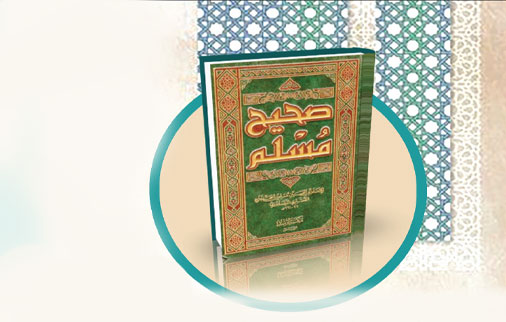
شرح كتاب الحج من صحيح مسلم – باب: تقديم الظُّعن مِنَ مزدلفة
- مَشروعيَّةُ تَقديمِ الضَّعَفةِ والنِّساءِ مِن مُزدلِفةَ إلى مِنًى قبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ وبعْدَ منتصْفِ اللَّيلِ لِيَرموا جَمْرةَ العَقبةِ
عن عبداللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتْ الجَمْرَة،َ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهْ، لَقَدْ غَلَّسْنَا؟ قَالَتْ: كَلَّا أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ. الحديث رواه مسلم في الحج (2/940) في الباب السابق، ورواه البخاري (1679) في كتاب الحج، باب: مَنْ قَدّمَ ضَعفةَ أهْله بليلٍ فيقفون بالمزدلفة ويَدْعُون، ويَقدُم إذا غَابَ القَمر.
في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبداللهِ وهو ابنُ كَيسانَ، القُرَشي التّميمي مولاهم، مَولى أسماء بنتِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ، ثقة، قال: إنَّ أسْماءَ بنتَ أبي بكْرٍ -رَضيَ اللهُ عنهما- قَالَتْ له «وهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ» أي: وهي نازلةٌ عند الدّار المَبْنيّة في مُزدلفة، وهي مَشهورةٌ في ذلك الزّمن في مُزْدلفة، فهي نزَلَتْ لَيلَةَ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ، بعدَ الإفاضةِ مِن عَرَفاتٍ إلى مُزْدَلِفةَ، والمُزدلِفةُ: كما مرّ معنا: اسمٌ للمكانِ الذي يَنزِلُ فيه الحَجيجُ بعْدَ الإفاضةِ مِنْ جبَلِ عَرَفاتٍ، ويَبيتونَ فيه لَيلةَ العاشرِ مِنْ ذي الحِجَّةِ، وفيه المَشعَرُ الحَرامُ، وتُسمَّى جَمْعاً، وتَبعُدُ عن عَرَفةَ حوالي (12) كم.إحياء أسماء لبعض الليل
فأحيَتْ أسْماءُ -رضي الله عنها- بعضَ اللَّيلِ، بالعِبادةِ والصَّلاةِ، ثمَّ قالت لِمَولاها عبداللهِ: يا بُنيَّ، هلْ غابَ القمَرُ؟ فأجابَها بـ«لا»، فواصَلَت إحياءَ لَيلِها بالصَّلاةِ والدُّعاءِ، كما في قوله: «فَصَلَّتْ سَاعَةً» أي: استَمرَّت في الصّلاة، ثُمَّ قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ» حتَّى غابَ القَمرُ، ومَغيبُ القمَرِ تلك اللَّيلةَ يَقَعُ عندَ أوائلِ الثُّلثِ الأخيرِ، قبْلَ الفجْرِ بنحْوِ ساعةٍ ونِصفٍ إلى ساعتينِ، وسَببُ سُؤالِها: لِتَعلَمَ كمْ بَقِيَ مِن اللَّيلِ؟ فقدْ كُفَّ بَصَرُها في آخر حَياتِها -رَضيَ اللهُ عنها-، قال الحافظ: ومَغيبُ القَمَر تلك الليلة يقع عند أوائل الثُّلث الأخير، ومَنْ ثَمَّ قَيّده الشافعي ومَنْ تَبعه بالنّصْف الثاني. انتهى. ثم انْصَرَفَت إلى مِنًى- وهو كما ذكرنا- وادٍ يُحيطُ به الجِبالُ، يقَعُ في شرْقِ مكَّةَ على الطَّريقِ بيْن مكَّةَ وجبَلِ عَرفةَ، ويَبعُدُ عن المسجِدِ الحرامِ نحوَ (6 كم) تَقريباً، وهو مَوقعُ رمْيِ الجَمراتِ، فلمَّا وصَلَتْ إليها، رمَتْ جَمرةَ العَقبةِ في آخِرِ اللَّيلِ قبْلَ الفَجرِ، ثمَّ رَجَعَت فصَلَّت الصُّبحَ في مَكانِها الذي نزَلَتْه في مِنى، فقالَ لها مَولاها: «يا هَنْتَاهُ» أي: يا هذِه، قال ابن الأثير: وتُسكّن الهاء التي في آخرها وتُضم، ويقال في التّثنية: يا هنتان في المُؤنث، وفي جَمْعه: يا هنتان وهنوات، وفي المذكر: يا هَن ويا هَنان ويا هنون، وأصْله مِنَ الهَن، ويُكنى به عن نكرة كلّ شيء، فقولك للمُذكّر: يا هَن، كقولك: يا رجل، وقولك للأنثى: يا هنة، كقولك: يا امْرأة.قوله: «لقد غَلَّسْنَا»
قوله: «لقد غَلَّسْنَا» أي: جِئنا بِغَلَسٍ، وهو ظَلامُ آخِرِ اللَّيلِ، والمَعنى: أنَّنا تَسرَّعنا في الرَّحيلِ مِن مُزْدَلِفةَ، ورَمْيِ الجَمْرةِ باللَّيلِ، فأجابَته بأنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ ورخَّصَ لِلظُّعُنِ، والظُّعُنِ: جَمْعُ ظَعينةٍ، وهي المرأةُ في الهَودجِ، ثمَّ أُطلِقَ على المَرأةِ مُطلقاً، أي: رَخَّص للنِّساءِ في النُّزولِ مِن مُزْدَلِفةَ إلى مِنًى، في آخِرِ اللَّيلِ قبلَ الفَجرِ، ليَكونَ أبعَدَ عن مَشقَّةِ الزِّحامِ. قال النووي -رحمه الله-: «إن النّبّي - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ للظُّعُن» بضم الظّاء والعين، وبإسكان العين أيضاً، وهنّ النّساء، الواحدة ظعينة، كسَفينة وسُفُن، وأصلُ الظّعينة: الهَودج الذي تكونُ فيه المَرأة على البَعير، فسمّيت المَرأةُ به مَجازًا، واشتُهر هذا المَجاز حتّى غلب، وخفيت الحقيقة، وظَعينة الرّجل امرأته اهـ. (شرح مسلم) (9/40)، وقال صاحب المُغني: لا نعلمُ خِلافاً في جَواز تقديم الضّعَفة بليلٍ مِنَ جمع إلى مِنى اهـ، وسبب سُؤالها: نشأ مِنْ عَمَاها الذي عَرَضَ لها في آخر عُمْرها -رضي الله عنها.قوله: «فارْتَحلنا»
قوله: «فارْتَحلنا» أي: إلى مِنَى «حتّى رَمَت الجَمْرة» أي: جَمْرة العَقَبة «ثمَّ» بعد رَمْيها «صَلّت» أي: صَلاةَ الصُّبْح «في مَنْزلها» بمِنَى «فقلت لها أي هنتاه» أي: يا هذه، وهو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة أو مفتوحة وإسْكانها أشهر ثمَّ تاء مثناة من فوق. قال الحافظ: واستدلّ بهذا الحديث على جواز الرّمي قبل طُلوع الشّمس، عند مَنْ خَصّ التّعجيل بالضّعفة، وعند مَنْ لمْ يُخصّص. وخالف في ذلك الحَنفيّة فقالوا: لا يَرمي جَمرة العَقبة إلا بعد طُلوع الشمس، فإنْ رَمى قبلَ طلوع الشّمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإنْ رَماها قبل الفَجر أعَادها، وبهذا قال أحمد، وإسحاق والجمهور، وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طُلوع الشّمس. وبه قال النخعي، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طُلوع الفجر: عطاء، وطاوس، والشعبي، والشافعي. واحْتجّ الجُمْهور: بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، واحتجّ إسْحاق بحديث ابن عباس: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لغِلْمان بني عبدالمطلب: «لا تَرْمُوا الجَمْرة حتّى تَطْلعَ الشّمْس» وهو حديثٌ حَسن، أخرجه أبو داود، والنسائي، والطّحاوي، وابن حبان... قال: وإذا كان مَنْ رخّص له، منع أنْ يَرمي قبلَ طُلوع الشّمْس، فمَنْ لمْ يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا. ويُجْمع بينه وبين حديثِ ابن عباس، بحَمل الأمر في حديث ابن عباس على النّدْب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي: من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله، وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذر: السُّنّة ألا يَرْمي إلا بعد طُلوع الشّمس، كما فَعلَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يَجوز الرّمي قبل طُلوع الفجر؛ لأنّ فاعله مُخالفٌ للسّنّة، ومَنْ رَمَى حينئذ فلا إعَادة عليه؛ إذْ لا أعْلم أحداً قال: لا يُجْزئه. قال الحافظ: واسْتدلّ به أيضاً: على إسْقاط الوقُوف بالمَشْعر الحَرام عن الضّعَفة، ولا دلالة فيه؛ لأنّ رواية أسْماء، ساكتة عن الوُقُوف، وقد بيّنته رواية ابن عمر التي قبلها.اختلاف السلف في هذه المسألة
وقد اختلفَ السلفُ في هذه المسألة، فكان بعضُهم يقول: مَنْ مَرّ بمُزْدلفة، فلمْ يَنزلْ بها فعليه دَمٌ، ومَنْ نَزَل بها، ثمّ دَفَع منْها، في أيّ وقتٍ كان مِنَ الليل، فلا دَمَ عليه، ولو لم يقفْ مع الإمام، وقال مجاهد، وقتادة، والزُّهري، والثّوري: مَنْ لمْ يقفْ بها، فقد ضَيّع نُسُكاً وعليه دَمٌ، وهو قولُ أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وروي عن عطاء، وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاً وإنّما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. وذهب ابن بنت الشافعي، وابن خزيمة إلى أنّ الوقُوف بها رُكنٌ لا يتمّ الحَجّ إلا به. وأشار ابن المنذر إلى تَرْجيحه، ونقله ابن المنذر، عن علقمة، والنخعي، والعجبُ أنّهم قالوا: مَنْ لمْ يقف بها، فاته الحج، ويَجعل إحْرامه عُمْرة. واحتجّ الطّحاوي: بأنّ الله لمْ يذكر الوقوف، وإنّما قال: {فاذْكُروا اللهَ عندَ المَشْعرِ الحَرَام}. وقد أجْمعوا على أنّ مَنْ وَقَفَ بها بغير ذِكْر، أنّ حَجّه تَامٌّ، فإذا كان الذّكر المَذكور في الكتاب، ليس مِنْ صُلب الحج، فالمَوطن الذي يكون الذّكر فيه، أحْرَى أنْ لا يكون فرْضاً. قال: وما احتجوا به منْ حديث عروة بن مضرس- وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة - رفعه قال: «مَنْ شَهِدَ معنا صلاة الفَجر بالمُزْدلفة، وكان قد وَقفَ قبلَ ذلك بعَرَفة ليلاً أو نَهاراً، فقد تَمّ حَجّه». لإجماعهم أنّه لو بات بها، ووقف ونام عن الصلاة، فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أنّ حجّه تام. انتهى. وحديث عروة: أخرجه أصحابُ السنن، وصحّحه ابن حبان، والدارقطني، والحاكم ولفظ أبي داود عنه: أتَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمَوقف- يعني بجَمع - قلت: جئتُ يا رسُول الله، مِنْ جبل طيئ، فأكللتُ مَطيّتي، وأتْعبتُ نفسِي، والله ما تركتُ مِنْ جبلٍ إلا وَقَفتُ عليه فهل لي مِنْ حَج؟ فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «منْ أدركَ مَعنا هذه الصّلاة، وأتى عَرفات قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تمّ حَجّه، وقَضَى تَفَثه». وللنسائي: «مَنْ أدْركَ جَمْعاً مع الإمامِ والناس، حتّى يُفيضُوا فقدْ أدْرك الحَجّ، ومَنْ لمْ يُدْرك مع الإمامِ والناس، فلمْ يُدْرك»، وقد ارْتكبَ ابنُ حزم الشّطط، فزَعم أنّه مَنْ لمْ يُصلّ صلاة الصّبْح بمُزْدلفة مع الإمام، أنّ الحَج يفوته، الْتزاماً لما ألْزمه به الطّحاوي، ولمْ يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجْزاء، كما حكاه الطّحاوي، وعند الحنفية: يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. انتهى باختصار (الفتح) (3/528-529).فوائد الحديث
- مَشروعيَّةُ تَقديمِ الضَّعَفةِ والنِّساءِ مِن مُزدلِفةَ إلى مِنًى، قبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وبعْدَ منتصْفِ اللَّيلِ، لِيَرموا جَمْرةَ العَقبةِ.
- وفي الحديث التَّيسيرِ على الناسِ، ورَفْعِ المَشقَّةِ عنهم، والرَحمة بالضُّعفاءِ والنِّساءِ، وقد ظَهَرَ هذا جَلِيّاً في مَناسِكِ الحجِّ، قال اللهُ تعالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185)، وقال -سبحانه-: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78).




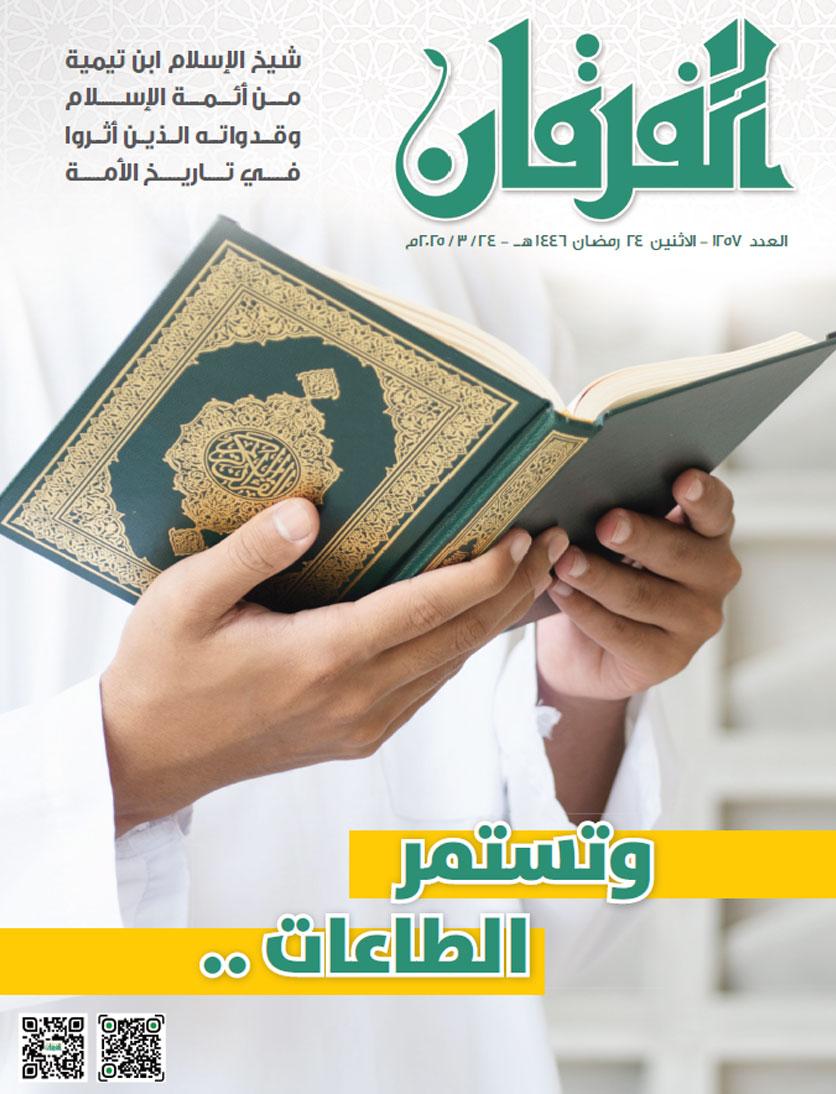







لاتوجد تعليقات