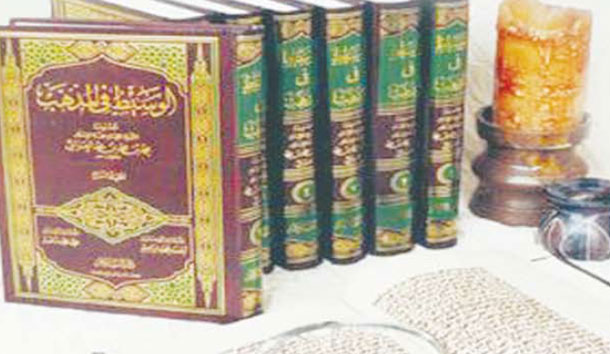
ضوابط الرد على المخالف- من الأدلة المختلف فيها العرْف والاستحسان وسد الذرائع
استكمالا للحديث عن ضوابط الرد على المخالف نتكلم اليوم عن الأدلة المختلف فيها وهو العرف، والعرف هو ما جَرى عليه الناس أو اعتادوه في قول أو فعل وهو ثلاثة أنواع: ما جرى عليه الناس من قول أو فعل يوافق الشرع، فهذا عُرف معتبرٌ بالشرع، وما جرى عليه الناس مما يخالف الشرع، فهذا عرف غير معتبر، والنوع الثالث هو ما جرى عليه الناس، ولا يخالف ولا يوافق الشرع.
دليل العرف في القرآن الكريم
ودليل العرف: كل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف، كقوله -تعالى-: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: 228، أي: ولهن على الرجال من الحق؛ مثل ما للرجال عليهن، فليؤدّ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، أي: إلى العرف والعادة الجارية في ذلك البلد والزمان، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص والعوائد.
وقوله -تعالى- {وعاشروهن بالمعروف} النساء: 19. فلم يحدد الله شيئا معلوما، فيشمل ذلك الصحبة الجميلة، وبذل الإحسان، والنفقة والكسوة بحسب الزمان والمكان، فأحال إلى العرف، ولكل مجتمع عادته وعرفه في التعامل، فلا تحكم على هذا المجتمع بعرف الآخر.
وكذا قوله -تعالى-: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: 232، فلم يقل كيف يتراضون؟ ولا قال: لا بد أن يتراضوا بطريقة كذا ؟ بل إذا اصطلحوا على طريقة مشى عليها العرف الذي بينهم فلا مانع، بشرط ألا يكون هناك شيء محرم أو خلاف الشرع؛ ولذلك يقولون: الصلح سيد الأحكام، وهذا من تطبيقات قاعدة العادة محكمة. ويقول -تعالى- أيضا: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: 231، أيضا هنا في هذه الآية أحال على العرف، فلم يقل: أمسكها على وصف كذا، وفارقها على وصف كذا، بل قال: أمسكها بمعروف أو فارقها بمعروف، بحسب ما جرى عليه العرف عند الناس.
ومنه قوله -تعالى-: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المائدة: 89، لم يبين قدر الإطعام، بل أحال إلى أوسط ما نطعم به أهلنا، وذلك مما يتفاوت فيه الناس بحسب البلاد والزمن، وهكذا.
دليل العرف في الأحاديث النبوية
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته الطويلة في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، بالمعروف». أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث (1218).
فقوله: «ولهن» أي: للنساء، «عليكم» أيها الأزواج، «رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، أي: بما جرت به العادة، فلم يقل: كل امرأة عليك أنْ ترزقها مثل ما يرزق ذلك الرجل، أو تكسوها مثل ما يكسوها فلان، بل قال: «بالمعروف»، ومعلوم أنَّ الغني غير الفقير، فالمرجع إلى العادة؛ والعادة محكّمة، يحتكم إليها في مثل هذه الأمور.
وأيضاً: لما جاءت هند بنت عتبة -رضي الله عنها- تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، تقول: يا رسول الله، إنه رجل شحيح - أي لا ينفق إلا قليلا - فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، حديث (2211)، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند، حديث (1714).
فلم يقل لها: خُذي وسكت، وأباح لها مال زوجها، لا، بل قال: خذي من مال هذا الرجل بالقَدْر الذي جرى العرف أن مثلكِ وولدك يكتفي به.
قواعد الفقهاء
وقد قعّد الفقهاء قواعد في هذا الأمر ومنها:
1- قاعدة: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، ولا ضَابِطَ لهُ فيه، وَلَا فِي اللُّغَةِ، يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ.
2- قاعدة: العادة محكمة.
3- قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا، إلا ما خالف الشرع.
4- قاعدة: المفتي لا يفتي في معاملات أهل بلد، إلا إذا عرف عرفهم، والفتوى المبنية على العرف تتغير بتغيره، فما تعارف الناس عليه مثلاً في البيع والشراء، أو التقابض؛ اُعْتُبِرَ.
5- قاعدة: الكنايات يرجع فيها إلى النية، وإلا رجع إلى العرف وإلا إلى اللغة. وغيرها من القواعد، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 93) والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص82 -83).
الاستحسان
وهو معدود في الأدلة المختلف فيها، وتعريفه لغةً: مأخوذ من الحُسن، وهو ضدُّ القُبح، واستحسن الشيء أي: عدّه حسناً، والاستحسان اصطلاحاً عرف بتعريفات عدة، منها:
1– تعريف أبي الحسن الكرخي من الحنفية؛ حيث عرفه بقوله: «هو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى منه».
2– تعريف القاضي أبي يعلى من الحنابلة؛ حيث عرفه بقوله: «ترك الحُكم، إلى حكمٍ هو أولى منه».
3- وذكر الغزالي وابن قدامة للاستحسان ثلاثة معان:
أ - أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ب - أنه دليل يَنْقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
ج - العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة. «وهو تعريف الكرخي السابق، وبه عرّفه الطوفي أيضاً».
4–تعريف المالكية، فيما ذكره ابن خويز منداد بقوله: «هو العمل بأقوى الدليلين». فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين:
- الأول: العُدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل خاصٍ أقوى، وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح للاسْتحسان.
- الثاني: ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل، وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان.
وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو ردّه.
وعند التحقيق ليس منها: ما يستحسنه المجتهد بعقله فقط، فهذا المعنى اتفق العلماء على أنه باطل، ولا يجوز أنْ يتكلم أحد في شرع الله بالعقل المجرّد.
- واشتهر عن الإمام الشافعي ردّه للاستحسان، وتشنيعه على مَنْ قال به، كما في كتابه (الرسالة)، وكتابه (الأم)، بل إنه ألف كتاباً سماه: (إبطال الاستحسان)، ومن أقواله في ذلك:
أ – قوله: «من اسْتَحسن فقد شرَّع!».
ب – وقوله في الرسالة: «والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها، أو تشبيهٍ على عينٍ قائمة، وهذا يبين أنّ حراماً على أحد أنْ يقول بالاستحسان؛ إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ».
ج - وقوله في الأم: «باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله، ثم حكم رسول الله، ثم حكم المسلمين دليل على أنْ لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا ألا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك: الكتاب ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أنْ يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجباً، ولا في واحد من هذه المعاني».
إلى غير ذلك من النقول عن الإمام -رحمه الله- التي تفيد ردّه للاستحسان، والتشنيع على مَنْ عَمِل به، لكنّا وجدنا الإمام -رحمه الله- يفتي بالاستحسان أحياناً، وأحياناً يستحسن بعض المسائل ويعبّر عنها بقوله: أسْتحبُّ بدل أستحسن، مع أنهما في الحقيقة سواء، كما قال السرخسي.َ
ومن الفروع التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان ما يلي:
1–الاستحلاف على المصحف: حيث يقول كما في الأم: «وقد كان من حكام الآفاق مَن يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن».
2–العمرة في أشهر الحج: حيث سئل عنها فقال: «حسنة، أستحسنها، وهي أحب منها بعد الحج، لقول الله -عز وجل-: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} البقرة. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دخلت العمرة في الحج».
3–وقال في دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين: «هذا حسن، وأستحسنه لمن فعل».
وهذا مما يُبين أنّ الشافعي -رحمه الله- إنما أراد بذمّه للاستحسان؛ ما يستحسنه الفقيه برأيه من غير دليل، أو ما يخالفه الدليل، وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان، وهذا المعنى اتفق الفقهاء على أنه باطلٌ لا يجوز، وهو أنْ يتكلم أحدٌ في شرع الله -تعالى- بالعقل المجرّد؛ ولذا قيل: مَن استحسن فقد شرّع.
أما المعاني الأخرى المذكورة للاستحسان، والمراد به، فهي تدخل في العمل بالكتاب والسُّنة، والقياس، والعرف، والمصالح المرسلة، وغير ذلك، وبهذا يخرج الاستحسان إلى معان متفق عليها غير مختلف فيها.
سدُّ الذّرائع
ومن الأدلة المختلف فيها: سد الذرائع، والذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة: الوسيلة إلى الشيء.
ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: ما كان ظاهره الإباحة، لكنه يُفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام.
فالمقصود بقولهم: (سد الذرائع)، أي: سد الطرق المؤدية إلى الفساد، وقطع الأسباب الموصلة إليه، وحسم مادة الفساد، من أصلها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والذَّرِيعةُ ما كان وَسِيلَةً وطرِيقًا إلى الشَّيءِ، لكنْ صارَتْ في عُرْفِ الفُقهاءِ عِبارةً عَمَّا أَفَضْت إلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، ولو تَجَرَّدَتْ عن ذلك الاِفْضاءِ لم يَكنْ فِيها مَفسدَةٌ، ولِهذا قيل: الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذي ظَاهِرُهُ أَنَّه مُباحٌ، وهو وَسِيلَةٌ إلى فِعْلِ المُحَرَّمِ، أَمَّا إذا أَفْضتْ إلى فَسَادٍ ليس هو فِعلًا، كإِفْضاءِ شُرْبِ الخمْرِ إلى السُّكْرِ، وإِفْضاءِ الزِّنا إلى اخْتِلَاطِ المِياه، أَو كان الشَّيْءُ نَفْسُهُ فَسَادًا، كالْقَتْلِ والظُّلْمِ فهذا ليس مِنْ هذا البابِ، فإِنَّا نَعْلَمُ إنَّمَا حُرِّمَتْ الْأَشْيَاءُ لِكَوْنِهَا في نَفسها فَسادًا، بِحيثُ تَكُونُ ضرراً لا منْفَعَةَ فيه، أَو لكَوْنِها مُفْضِيَةً إلى فَسَادٍ بِحيْثُ تَكُونُ هي في نفسِها فِيها مَنْفَعَةٌ، وهي مُفْضِيَةٌ إلى ضَرَرٍ أَكْثَرَ منها فتَحْرُم، فإِنْ كَان ذلك الْفَسَادُ فِعْلَ مَحْظُورٍ، سُمِّيَتْ ذَرِيعَةً، وإِلَّا سُمِّيَتْ سَبَبًا ومُقْتضيًا، ونحوَ ذلك مِنْ الْأَسماءِ الْمَشهورةِ.
أقسام الذرائع
هذهِ الذَّرَائِعُ إذا كانت تُفْضِي إلى المُحرَّمِ غالبا؛ فإِنَّه يُحَرِّمُها مُطْلقًا، وكذلك إنْ كانت قد تُفْضِي، وقد لا تُفْضي، لكنَّ الطَّبْعَ مُتَقَاضٍ لِإِفْضائِها، وأَمَّا إنْ كانتْ إنَّما تُفْضي أَحيانًا، فإِنْ لم يكُنْ فيها مصْلَحَةٌ راجحةٌ على هذا الإِفْضَاءِ القَلِيلِ، وإِلَّا حَرَّمَها أَيضًا، ثُمَّ هذه الذَّرَائِعُ منها ما يُفْضِي إلى المَكْرُوهِ بدونِ قَصْدِ فاعلها.
ومِنها ما تَكونُ إباحتُها مُفْضيَةً للتَّوَسُّلِ بِها إلى الْمَحارِمِ، فهذا القسم الثاني يجامع الحيل؛ بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة وقد لا يقترن، كما أنّ الحيل قد تكون بالذرائع، وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل ليست ذرائع فصارت الأقسام ثلاثة:
- الأول: ما هو ذريعة وهو مما يحتال به، كالجمع بين البيع والسلف، وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة، وبأكثر أخرى. وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأ، وكقرض بني آدم.
- الثاني: ما هو ذريعة لا يحتال بها؛ كسبِّ الأوثان، فإنه ذريعة إلى سبّ الله -تعالى-، وكذلك سب الرجل والد غيره، فإنه ذريعة إلى أنْ يسبّ والده، وإنْ كان هذان لا يقصدهما مؤمن.
- الثالث: ما يُحتال به من المباحات في الأصل، كبيع النصاب في أثناء الحول؛ فراراً من الزكاة، وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة.
إلى أنْ قال: والغَرَضُ هنا: أَنَّ الذَّرائِعَ حَرَّمَها الشَّارع، وإِنْ لم يَقْصدْ بها الْمُحَرَّمَ خَشْيَةَ إفضائِها إلى المُحَرَّمِ، فإِذا قَصدَ بالشَّيْءِ نَفسَ الْمُحَرَّمِ؛ كان أَوْلَى بالتَّحْرِيمِ مِنْ الذَّرَائِع.
عِلَّةُ التَّحرِيمِ في مسائل العِينَة
وبِهذا التَّحْرِيرِ يَظهرُ عِلَّةُ التَّحرِيمِ في مسائل العِينَة وأَمثالها، وإِنْ لم يقْصِدْ الْبائِعُ الرِّبا؛ لأَنَّ هذِهِ الْمُعَاملَةَ يَغْلِبُ فيها قَصدُ الرِّبَا فَيَصِيرُ ذَرِيعَةً، فَيَسُدُّ هذا البابَ لئَلَّا يَتَّخِذَهُ النَّاسُ ذَرِيعَةً إلَى الرِّبَا ويقولُ الْقَائِلُ: لَمْ أَقْصِدْ بِهِ ذلك، ولِئَلَّا يَدعُو الإِنسانُ فِعْلَهُ مَرَّةً إلى أَنْ يَقْصِدَ مَرَّةً أُخْرَى، ولِئَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ جِنسَ هذه المُعاملةِ حَلالٌ، ولَا يُمَيِّزَ بينَ الْقَصْدِ وعَدَمِه، ولئَلَّا يَفْعلها الْإِنسانُ مع قَصْدٍ خَفِيٍّ، يَخْفَى مِنْ نَفْسهِ على نَفْسِه.
سَدِّ الفسادِ وحَسْمِ مادَّةِ الشَّرِّ
ولِلشَّرِيعَةِ أَسْرَارٌ فِي سَدِّ الفسادِ وحَسْمِ مادَّةِ الشَّرِّ، لِعِلْمِ الشَّارِعِ ما جُبِلتْ عليه النُّفُوسُ، وبما يَخْفَى على النَّاسِ مِنْ خَفِيِّ هُدَاهَا الَّذِي لا يَزالُ يَسْرِي فيها، حتَّى يَقُودَها إلَى الهَلَكَةِ.
فَمَنْ تَحَذْلَقَ على الشَّارِعِ واعْتَقَدَ في بعضِ الْمُحَرَّمَاتِ، أَنَّهُ إنَّما حُرِّمَ لِعلَّةِ كذا وتِلك العِلَّةُ مَقْصُودةٌ فيه فاسْتَبَاحَهُ بِهذا التَّأْوِيلِ فهو ظَلُومٌ لِنَفْسِهِ، جهولٌ بِأَمْرِ ربِّه، وهو إنْ نَجَا مِنْ الْكُفْرِ لم يَنْجُ غالبًا مِنْ بِدْعةٍ أَو فِسْقٍ، أَوْ قِلَّةِ فِقْهٍ فِي الدِّينِ، وعَدَمِ بصِيرةٍ»، انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 172- 174) باختصار.











لاتوجد تعليقات