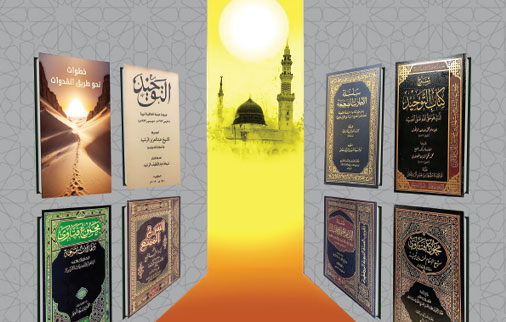
محاضرات منتدى تراث الرمضاني الخامس – أعلام وقدوات أثروا في تاريخ الأمة
تحت شعار: (أعلام وقدوات أثروا في تاريخ الأمة)، أطلق «قطاع العلاقات الإعلام والتدريب» بجمعية إحياء التراث الإسلامي (منتدى تراث الرمضاني الخامس) الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين 3 رمضان 1446هـ، الموافق 3 مارس 2025م، ويشمل المنتدى لهذا العام محاضرات عدة، يلقيها مشايخ من داخل الكويت وخارجها، عبر البث المباشر (زووم) من الساعة (10.30 - 11.30) صباحًا. ويأتي منتدى هذا العام ليسلط الضوء على جهود العلماء والأئمة الأعلام في حفظ الدين ونشره، مع بيان أثرهم في توجيه الأمة نحو الصراط المستقيم، هؤلاء الأعلام الذين وقفوا سدًّا منيعًا في وجه التحريف والبدع، فبيّنوا للناس أصول الدين، ودعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة، مجتهدين في تعليم الأحكام، وبيان الحلال والحرام، ونشر قيم الإسلام السمحة.
المحاضرة 2 - إمام أهل السنة - أحمد بن حنبل
- عاش الإمام أحمد يتيما وقامت أمه على رعايته وتنشئته على أحسن ما يكون فحفظ القرآن رحمه الله ثم انكب على طلب علم الحديث بنهم عجيب وحب لهذا العلم
- بدأ الإمام أحمد رحلته في طلب الحديث سنة 186 وهو في الثانية والعشرين من عمره واتجه إلى البصرة والكوفة ثم انتقل إلى الرقة في الشام ثم إلى اليمن ثم إلى الحجاز والتقى عددا كبيرا من علماء الأمة وفقهائها العظام
- كان لدى الإمام أحمد شغف بطلب الحديث وحرص على المجالس والحلقات التي يُدرّس فيها المشايخ هذا العلم وكان يسمع ويكتب حتى إنه بلغ مبلغا عظيما في هذا العلم
- جلس الإمام أحمد للتدريس والفتيا في بغداد سنة 204 من الهجرة سنة 819 من الميلاد ومن تقدير الله عزوجل أن تلك السنة هي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي فكان الإمام أحمد خلفا له
- لزم الإمام أحمد رحمه الله عددًا من تلاميذه المبرزين من أشهرهم أبو بكر المروزي وكان مقربا إلى الإمام أحمد رحمه الله مقدمًا عنده لعلمه وفضله وأمانته
- توفي الإمام أحمد رحمه الله في 12 ربيع الآخر سنة 241 من الهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والتدريس والجهاد في سبيل الله بالكلمة والثبات على منهج السلف وبيانه والتحذير من البدع والأهواء وأهلها
- تعرض الإمام أحمد لمحنة وابتلاء عظيم واختبر في عقيدته في مسألة عمّ فيها البلاء في عهد الخليفة المأمون الذي زيّن له أهل البدع القول بخلق القرآن لكن الإمام رحمه الله لم تضعف عزيمته ولم يضعف إيمانه ولم يتنازل عن عقيدته بل ثبت وظل صامدًا عليها
بداية أشكر الإخوة في قطاع الإعلام والتدريب، وأخص بالشكر رئيس القطاع الأخ الفاضل: سالم الناشي على هذه الاستضافة، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وعند الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-، فهو حديث عن أحد أئمه الهدى الذين ازدانت بهم القرون الثلاثة الهجرية الأولى، وإذا قرأت في سيرة هذا الإمام العلم فإنك تجد فيه الدين والخلق والآداب، وتجد فيه الاتباع الصادق لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والتطبيق لها وملازمتها؛ حيث اجتمع الناس على الثناء عليه وعلى الالتفاف حوله وتلقي العلم عنه.
ولد الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في بيت كريم من بيوت بنى شيبان، فأبوه وأمه كلاهما من بنى شيبان، وقد ولد الإمام أحمد -رحمه الله- سنة 164 من الهجرة وشاء الله -عز وجل- أن يُتوفى أبوه قبل أن يخرج إلى الدنيا، فعاش يتيما، وقامت أمه على رعايته وتنشئته على أحسن ما يكون، وحرصت على تعليمه وملازمته للقرآن وحفظه، فحفظ القرآن -رحمه الله-، ثم انكب على طلب علم الحديث بنهم عجيب وحب لهذا العلم، وكان نشيطا في هذا الباب، وكان يخرج في الصباح الباكر إلى حلقة شيخه، وانتقل إلى ملازمة الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (تلميذ أبي حنيفة)، وكان أول من اعتلى منصب قاضي القضاة، وكان الإمام أبو يوسف له حلقة عظيمة يؤمها الناس وطلاب العلم والعلماء والقضاة على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم، فلزم الإمام أحمد حلقة أبى يوسف أربع سنوات، قيل: إنه كتب فيها ما يملأ ثلاثة صناديق.انتقاله إلى بغداد
ثم انتقل إلى بغداد فلزم حلقة هُشيم بن بشير السُلمِى (شيخ المحدثين في بغداد)، وكان عالم بغداد في ذلك العصر، ثم تتلمذ على نُعيم بن حماد وهو معدود من مشايخ البخاري، ثم على عبدالرحمن بن مهدى وأيضا هو من مشايخ البخاري ومسلم، ثم عمير بن خالد وغيرهم من الأئمة، وكان من المعهود والمشهور في ذلك العصر الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم وفي طلب الفقه، وفي هذه الفترة من فترات التاريخ الإسلامي كان الطلاب يسافرون إلى المشايخ في غير بلادهم إذا انتهوا من الأخذ على مشايخ البلد والاستفادة منهم وكتابة ما عندهم من الحديث والأسانيد، فإنهم ينتقلون إلى البلاد الأخرى، وكان هذا من عادات العلماء وطلاب العلم النابهين، لا يعوقهم في ذلك قلة المال ولا بعد المكان.رحلته في طلب الحديث
الإمام أحمد -رحمه الله- بدأ رحلته في طلب الحديث سنة 186 وهو في الثانية والعشرين من عمره، اتجه إلى البصرة والكوفة، ثم انتقل إلى الرقة في الشام ثم إلى اليمن ثم إلى الحجاز، والتقى عددا كبيرا من علماء الأمة وفقهائها العظام من أمثال يحيى بن سعيد القطان، وأبي داود الطيالسىّ صاحب المسند، ووكيع بن الجراح وهو أحد مشايخ الشافعي، وأبي معاوية الضرير محمد بن خازم، وسفيان بن عيينة، والتقى أيضا بالإمام الشافعي الذي لازمه الإمام أحمد وأخذ عنه الفقه وأصوله، وكان الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى الشيباني يقصد الإمام أحمد -رحمه الله-. وكان لدى الإمام أحمد -رحمه الله- شغف بطلب الحديث كما هو معلوم وكان حريصًا على المجالس والحلقات التي يُدرّس فيها المشايخ هذا العلم، وكان يسمع ويكتب حتى أنه بلغ مبلغا عظيما في هذا العلم، وظل يكتب حتى في سن متأخرة، وتشتهر عنه هذه المقالة لما سئل إلى متى تكتب الحديث وأنت في هذه السن؟ قال: (من المحبرة إلى المقبرة)، وهذا دليل على أن الإنسان لا يستغني عن طلب الحديث وطلب العلم والفقه، طول حياته يحتاج إلى النظر وإلى المراجعة وإلى السماع وإلى الاختلاط بالعلم وأهله.جلوسه للتدريس والفتيا
جلس الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- للتدريس وللفتيا في بغداد سنة 204 من الهجرة يعنى سنة 819 من الميلاد، ومن تقدير الله -عز وجل- أن سنة مئتين وأربع هي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي -رحمه الله- فكان الإمام أحمد -رحمه الله- خلفا له، وكان له حلقتان، حلقة في بيته خاصة بتلاميذه النابهين من طلبة العلم المبرزين، وله حلقة أخرى في المسجد يحضرها عامة الناس وطلاب العلم الباقين، وكان يعقد حلقته يوميا بعد صلاة العصر وكان يُملي الحديث في الغالب من كتابه، وكان يبالغ في الدقة ويتحرى الأمانة في النقل، مع أنه كانت له حافظة قوية حتى قال الإمام يحيى بن معين: إن الإمام أحمد -رحمه الله- كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني بطرقها وأسانيدها وإلا فالأحاديث النبوية لا تصل إلى هذا العدد، لكن المقصود أنه كان يحفظ الحديث ربما من خمسين وجها بخمسين طريق، فكانت له حافظة في هذا الباب نادرة.تلاميذ الإمام أحمد -رحمه الله-
ولزم الإمام أحمد -رحمه الله- عدد من تلاميذه المبرزين من أشهرهم أبو بكر المروزي وكان مقربا إلى الإمام أحمد -رحمه الله- مقدمًا عنده لعلمه وفضله وأمانته، حتى أن الإمام أحمد -رحمه الله- كان يقول: كل ما قاله على لساني فأنا قلته يقصد أبا بكر المروزي، وأيضًا من تلاميذه أبو بكر الأثرم، وإسحاق بن منصور التميمي، وإسحاق بن إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث. وكذلك من تلاميذه المشهورين المبرزين الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، وكذلك الإمام مسلم، والإمام أبو داوود السجستاني، والإمام بقيّ بن مخلد محدث الأندلس وحافظ الأندلس في الحديث، وله مسند وإن كان فُقد أكثره.مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-
الإمام أحمد -رحمه الله- كما تعلمون له مذهب فقهى، ولكنه لم يُصنّف ولم يُملِ في الفقه كتابا، بل كان يكره أن يُكتب شيء من آرائه وفتاويه، حتى جاء الإمام أبو بكر الخلال سنة 311 من الهجرة وهذا بعد وفاة الإمام فقام بجمع أقاويل وآراء وفتاوى الإمام أحمد -رحمه الله-، والإمام أبو بكر الخلال تتلمذ على تلميذ الإمام أحمد الخاص وهو أبو بكر المروزي، فكتب الخلال الجامع الكبير في نحو عشرين مجلدًا، وجلس في جامع الإمام المهدي ببغداد يُدَرس التلاميذ في هذه الحلقة المباركة مذهب الإمام أحمد الذي تناقله الناس بعد ذلك مدونا مكتوبا بعد أن كان روايات مبعثرة، فأبو بكر المروزي له فضل وحسنة في جمع مذهب الإمام أحمد. ثم جاء أبو القاسم الخرقي المتوفي سنة 334 من الهجرة، فلخص ما كتبه أبو بكر الخلال في هذه المجلدات الطويلة في كتاب وسماه مختصر الخرقي، كتاب مشهور عند الحنابلة وتلقاه الناس بالقبول من فقهاء الحنابلة شرحا وتعليقا حتى قيل: إن لهذا الكتاب ما يزيد على ثلاثمائة شرح، من أشهرها كتاب المغنى لابن قدامة المقدسي الذي جاء بعده بقرون.الإمام ابن قدامة -رحمه الله-
الإمام ابن قدامة ولد سنة 620 للهجرة، وقد شرح مختصر الخرقي، ويتميز كتاب المغني في الفقه بأنه لم يقتصر على جمع كلام الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد، بل تعداه إلى بيان اختلاف الروايات عن أحمد، ثم ذكر الأدلة لما اختاره الإمام أحمد، فكان ابن قدامة -كما قيل- له فضل على الحنابلة؛ لأنه نصر مذهبهم بالأدلة من القرآن والسنة فضلا عن أنه جمع أقوال الفقهاء الآخرين، يعنى ذكر مذهب أبى حنيفة والإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم؛ فقد كان يقارن أقوال الإمام أحمد بأقوال غيره من أئمة المسلمين، ثم جاء ابن تيمية الجد عبدالسلام بن عبدالله المتوفي سنة 652 هجريا، فكتب كتابًا حرر فيه مسائل المذهب، وسماه المحرر في الفقه. وانتشرت كتب المذهب الحنبلي بين الناس، ويتميز مذهب الإمام أحمد بالتمسك بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الصحيحة.إذا صح الحديث فهو مذهبي
الإمام أحمد -رحمه الله- لا يُقدّم على حديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قول أحد من الناس كائنا من كان، واشتهر في هذا، والأئمة الأربعة كلهم على هذا، فمقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي نُقلت عن الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن الفرق أن الإمام أحمد -رحمه الله- كان أوسع الأئمة علماً بالسنة، كما ذكرت أن ما كان يحفظه من الأحاديث بطرقها وأسانيدها تصل إلى مليون رواية -ألف ألف- وهذا لم يبلغه أحد من الأئمة قبله. فلهذا امتاز مذهب الإمام أحمد بموافقة السنة في كثير من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، كما أن مذهب الإمام أحمد يتميز باليسر والسهولة وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين، رحمة الله -تعالى- على الإمام أحمد.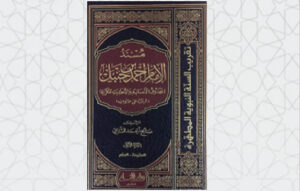
محنة الإمام أحمد -حمه الله-
الإمام أحمد -رحمه الله- تعرّض لمحنة، وابتلاء عظيم، واختبر في عقيدته، وذلك في مسألة عمّ فيها البلاء في عهد الخليفة المأمون بن الخليفة هارون الرشيد، فالخليفة المأمون زيّن له أهل البدع وعلى رأسهم ابن أبي داؤود القول بخلق القرآن، ومعنى القول بخلق القرآن هو أن القرآن الكريم مخلوق من المخلوقات، وأن الله -عزوجل- خلقه، تعالى الله عن ذلك، ويريدون بهذا القول المنكر نفي صفة الكلام عن الله -عز وجل-، وعندهم أن الله لا يوصف بأنه يتكلم وأنه يقول ويتكلم متى شاء، هذا لا شك أنه بدعة منكرة مخالفة للقرآن ومخالفة لما عليه القرون الثلاثة الأول من المسلمين، فكم جاء في القرآن الكريم {وقال ربك}، {وقال الله}، وقال -سبحانه وتعالى- {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}، {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ}، كما قال هذا ربنا -عزوجل- في كتابه! وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال الله -تعالى- هذه بدعة منكرة والعياذ بالله، يشمئز الإنسان من قبولها. والمأمون أعلن في سنة 218 من الهجرة دعوته إلى هذا القول المنكر، وأن القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، وحمل العلماء والفقهاء على قبول هذه البدعة، يعني أجبرهم عليها إجبارا، ومن أبى القول بها والرضوخ لهذه البدعة تعرض للتعذيب وتعرض للسجن، وبعضهم قُتل لما أعلن رفضه لهذه البدعة، وهذا يبين لنا خطر أهل البدع، وأنهم أحياناً أخطر من العدو الخارجي، من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما وصلوا إلى ما فعله المعتزلة في هذه البدعة بالمسلمين.موقف العلماء من الفتنة
العلماء منهم من امتنع وأعلن ذلك وتعرض للتعذيب والسجن والمنع من التدريس والإمامة، ومنهم من سكت ولم يتكلم؛ لأنه يعلم إذا تكلم سيذهب إلى السجن، ومنهم من وافق خوفاً وأخذ بالرخصة، يجوز لي أن أقول بهذا تقية كما قال الله -عزوجل-: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}، لكن الإمام أحمد -رحمه الله- ومعه جماعة من العلماء امتنعوا ورفضوا هذه البدعة المنكرة؛ فثبتهم الله -عزوجل-؛ فكبّلوا بالحديد وحملوا إلى المأمون الذي كان في طرسوس في الشام لينظر في أمره، وشاء الله -عزّوجل- أن يموت المأمون قبل وصول الإمام أحمد إليه، فعاد مرة أخرى مكبلا بالحديد إلى بغداد، وكان معه رجل يقال له محمد بن نوح لم يكن بتلك الشهرة في العلم، لكنه نصح الإمام أحمد نصيحة عظيمة، قال له: أنت رجل يُقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم إليك، فإياك أن تجيب، فاتق الله -عزوجل- واثبت لأمر الله، مع أنه ما كان مشهورا بالعلم لكن نطق بهذه النصيحة العظيمة للإمام أحمد.ثبات الإمام أحمد -رحمه الله-
وكان الإمام أحمد -رحمه الله- عند حسن الظن، فلم تضعف عزيمته ولم يضعف إيمانه، ولم يتنازل عن عقيدته، بل ثبت على ذلك ومكث في السجن عامين وثلث عام وهو صامد -رحمه الله-، وحمل إلى الخليفة المعتصم الذي واصل القول بهذه البدعة، القول بخلق القرآن، واتخذ مع الإمام أحمد وسائل الترغيب والترهيب لأجل أن يتكلم بكلمة تؤيدهم فيما يزعمون ويقولون، لكن الله -سبحانه وتعالى- حفظه من ذلك، وكان لا يزيد على قوله القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم إن الإمام أحمد -رحمه الله- تعرّض للضرب بالسياط دون رحمة، وأعيد للسجن مرات ومرات وهو يأبى أن يوافقهم على هذه البدعة حتى أطلق سراحه، لكنه منع من الاجتماع بالناس ومن التدريس والتعليم ونشر العلم في عهد الخليفة الواثق، لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة فقط.خلافة المتوكل
وقد استمرت هذه المحنة وهذه البدعة من سنة 218 إلى سنة 232 أكثر من عشرين سنة تقريبا، إلى أن تولى الخلافة المتوكل سنة 232 من الهجرة، فمنع القول بهذه البدعة، وهذه البدعة مفروضة على المسلمين وعلى علماء المسلمين وأئمة المسلمين وعلى المساجد والمدارس والمعاهد إلى أن رفع الله -سبحانه وتعالى- هذا البلاء على يد الخليفة المتوكل سنة 232، فمنع القول بخلق القرآن، ورد للإمام أحمد اعتباره وسمح له بالعودة إلى التدريس والتحديث في المساجد، وقد كُتب في هذه المحنة مؤلفات من شاء أن يرجع إليها يرجع إلى سير أعلام النبلاء، وكذلك الحافظ ابن الجوزي -رحمه الله- له كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد تعرّض فيه إلى سيرة الإمام أحمد بالتفصيل.مؤلفات الإمام أحمد -رحمه الله-
الإمام أحمد -رحمه الله- ترك عددا من المؤلفات في الحديث، من أشهرها وأعظمها المسند الذي ينسب إلى الإمام، مسند الإمام أحمد وفيه ما يقرب من ثلاثين ألف حديث بالمكرر، فالحديث قد يروى من أكثر من وجه وأكثر من طريق، وقد رتبه الإمام أحمد على أسماء الصحابة، فبدأ بالخلفاء الأربعة الأوائل مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم مسند علي حتى انتهى بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك ذكر مسانيد الصحابة، كل صحابي يذكر في مسنده ما جمع من حديثه، طبعا الإمام أحمد لم يشترط الصحة في هذا المسند كصحيح الإمام البخاري أو كصحيح الإمام مسلم، اللذين اشترطا ألا يذكرا إلا الأحاديث الصحيحة. أما الإمام أحمد كان يجمع لكنه يتحاشى المنكر والمكذوب لا يورده في المسند، لكن قد يكون فيه بعض الأحاديث التي في أسانيدها كلام والمصلحة من إيراد الحديث مع وجود ضعف في سنده أنك تقف على الحديث، فإذا قيل لك هل هناك حديث كذا وكذا؟ تقول نعم ورد حديث في هذا، لكن الحديث فيه ضعف، وقد رواه الإمام أحمد وقليل ما كان الإمام أحمد يعلق على الأحاديث، لكنه انتخب هذا المسند وشرع في تأليفه بعد ما جاوز السادسة والثلاثين، ويُنقل عنه -رحمه الله- أنه قال: استخلصت المسند من 750 ألف حديث! بطرق متنوعة استخلص منها مسنده الذي هو 30 ألف حديث. أيضا من كتبه المشهورة كتاب السنة الذي كتبه ابنه عبدالله، وكان من المهتمين بالحديث وكتابة الحديث، ومن كتبه أيضاً الصلاة وما يلزم فيها مختصر، وكذلك من كتبه الزهد والورع والإيمان، وكتاب الأشربة وكتاب فضائل الصحابة في مجلدين كتاب جميل ونفيس. وكتاب المسائل، هذه كلها كتب مطبوعة ومتداولة.وفاة الإمام أحمد -رحمه الله-
بعد حياة حافلة بالعلم والتدريس والجهاد في سبيل الله بالكلمة والثبات على منهج السلف وبيانه، والتحذير من البدع والأهواء وأهلها، توفي الإمام أحمد -رحمه الله- في 12 ربيع الآخر سنة 241 من الهجرة الموافق سنة 855 من الميلاد عن عمر يناهز 77 عاما -رحمه الله تعالى-، ودفن في بغداد، ومدفنه معروف ومشهور، رحمة الله -تعالى- على الإمام أحمد ورضي عنه، ونسأل الله -عزوجل- أن يجمعنا معه في دار النعيم، وهناك كتب ألفت في مناقب الإمام أحمد وسيرته وحياته، منها: كتاب ابن الجوزي مناقب الإمام أحمد، كذلك ما كتبه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وما كتبه ابن خلاكان في وفايات الأعيان، أيضًا من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة له كتاب جميل اسمه أحمد بن حنبل حياته وعصره.











لاتوجد تعليقات