
شبهة المساواة بين الأديان
إن وسائل المعرفة في عصرنا الحالي تعددت، وأصبحت تلك الوسائل وقنواتها المختلفة من الكثرة ما يصعب معه إحصاؤها، وبعض هذه الوسائل والقنوات ولاسيما (الإنترنت) والفضائيات اتخذت من الإساءة للدين الإسلامي والطعن على ثوابته، ومقدساته، هدفاً لها؛ مما جعل بعض الشباب تحت وطأة الهجوم الضاغط عرضة للشك، أو العجز عن الرد في أحسن الأحوال، فتزلزلت عقائد بعضهم، التي هي من الأساس هشة، وهوى دينهم الذي لم يكن راسخاً ولا مبنياً على أسس ثابتة من صحيح الدين، واليوم نتكلم عن شبهة جديدة وهي شبهة المساواة بين الأديان:
المساواة بين الأديان شبهة مشتركة، يقول بها عديد من أصحاب العقائد الباطلة، والملاحدة، والمساواة هنا لا تعني مجرد التعامل في الواقع مع جميع أتباع الأديان بالتساوي في الحقوق والحريات، فهذه وإن كانت مسألة تختلف باختلاف القوانين والدول، لكن موقف الإسلام منها واضح لا لبس فيه، فحفظ الإسلام لحقوق غير المنتمين له وحرياتهم، حقيقة كائنة في مبادئه وأحكامه، أما قضية المساواة بين الأديان، التي نحن بصدد الحديث عنها، فهي دعوى لا يقول بها إلا من لا دين له،؛ لأن معناها: عدم امتلاك أي دين للحقيقة المطلقة؛ ومن ثم فهي كلها متساوية!!، فالقول بهذه المساواة هو في الحقيقة مساواة بين الحق والباطل، إما على قاعدة أنها جميعاً حق!!، أو أنها جميعاً باطل!؛ أو أنها جميعاً مشكوك فيها!، والله -تعالى- يقول في كتابه: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ} سورة يونس، آية32.
تلاف الديانات سنة قدرية
اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم حقيقة واقعة، قدرها الله -تعالى- وقضاها؛ لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار، يقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} سورة هود، آيات 118، 119, فالمراد بالاختلاف هنا: الاختلاف في الدين، وإنما لم يحمل الله -تعالى- كل المكلفين على دين الحق؛ لأن هذا ينافي ما جبلهم عليه، من الإرادة، وحرية الاختيار؛ لذلك نجد في أحكام الإسلام ما يتعلق بتعامل المسلمين مع غير المسلمين، وينظم العلاقة بينهم على المستويين الفردي والجمعي، وهذا يدل على أن الإسلام مع تأكيده على أنه الحق الذي ليس غيره إلا الضلال، لكنه أيضاً لا يفرض على الآخرين سلوك سبيله، بل يتركهم على أصل ما خلقوا عليه، من حرية الإرادة، ولكن مع تحمل مسؤولية الاختيار، فهي إذا ليست حرية بلا تبعة، إنما الحرية في ذاتها تحمل معنى التكليف بحسن الاختيار؛لأنه لم يسوَّ فيها بين كل الطرق، إنما قال هذا طريق الخير فسلوكه يوصل إلى السلامة، وهذا طريق الشر وسلوكه يوصل إلى الهلاك، {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)}، سورة الشمس، آيات 7: 10.
القول بالمساواة بين الأديان تناقض
الديانات إما سماوية أو أرضية، سماوية: أي أن مؤسسيها ادعوا أن وحياً من السماء يتنزل عليهم، وأقاموا على ذلك البراهين، وأرضية: أي أن مؤسسيها لم يدعوا ارتباطاً بوحي يتنزل عليهم، أو زعموا ذلك من غير دليل، السماوية كاليهودية والمسيحية والإسلام، والأرضية كالهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية، ويلحق بها السيخية، والبهائية، والأحمدية. وحين نقول بالتسوية بين هذه الديانات، فإنه يحق لنا أن نسأل عن أسس هذه التسوية، فإن قيل على أساس أنها جميعاً موجودة بالفعل، قلنا هذا غير منطقي؛ لأنه تسوية بين الأضداد، فهناك ديانات توحيدية، وأخرى تقول بتعدد الآلهة، وثالثة لا تتعرض لمسألة وجود الإله أصلاً، وإن قيل على أساس أنها جميعاً تدعو للفضائل، قلنا مرجعية الفضائل في الأديان السماوية تعليمات إلهية، ومرجعيتها في الأديان الأرضية إلى تعليمات المؤسس لها، أو الأعراف السائدة؛ ومن ثم فإن الأشياء التي يعدها دين كالإسلام مثلاً من الفضائل، قد تكون كذلك في دين كالبهائية أو السيخية أو لا تكون.
الأديان ليست كلها حق
المعيار الذي يجب أن يحتكم إليه الإنسان في معرفة الحق والباطل، والتمييز بين الأديان من حيث مدى صوابها من عدمه، ليس هو مقدار ما تدعو إليه من الفضائل، ولا عدد من ينتمي إليها من أتباع، إنما مقدار ما يحمله الدين في ذاته من براهين، على صدق انتسابه إلى الله.
والبراهين المدللة على صدق نسبة ذلك الدين إلى الله، هي البراهين نفسها المؤكدة لوجود الله؛ لأن إرسال الرسل هو أحد الأدلة المهمة على وجود الله، فالبرهان، هو الفيصل، وحين ثبوته، لا يحق لأحد أن يشكك، أو ينفي شيئاً صح بالدليل أنه أمر من الله، لأن ثبوت وجود المرسِل (الله)؛ بثبوت صدق المرسَل (الرسول)، يعني صحة كل ما جاء به من عقائد وشرائع.
البراهين الدالة على أن الإسلام هو الحق المطلق
هناك عديد من البراهين التي تدل على أن الإسلام دين الحق، ويمكن إجمالها في دليلين:
- الأول: محمد صلى الله عليه وسلم ؛ من حيث تاريخه السابق على النبوة؛ فأخلاقه، وما اشتهر عنه من الصدق والأمانة، يدل على أنه شخصية محل ثقة، يصعب اتهامها بالتقول على الله؛ وكذلك من حيث الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي عليه بشهادة ناس ممن آمنوا به، فقد كانوا يسمعون صوتاً كصلصلة الجرس، ويرونه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، ويشعرون بثقل في جسده حتى لا تستطيع أن تتحمله الدابة التي يركب عليها؛ ومن حيث المعجزات المادية التي جرت على يديه.
- الثاني: القرآن الكريم؛ من حيث ما اشتمل عليه من معجزات، علمية، وتاريخية، وتشريعية، ونفسية، وبيانية، وهي كلها على التفصيل والإجمال دامغة الدلالة على أن مصدر القرآن هو الله -سبحانه- خالق هذا الكون. «وسوف يرد تفصيل ذلك كله في مقالات لاحقة إن شاء الله».
ومن مجموع هذين الدليلين، يتحصل لنا أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم كله حق، ويترتب على ذلك أن دينه هو آخر الأديان، وأن شرعه ناسخ لما سبقه من الشرائع؛ لأنه أخبر بذلك، ومن ثم فلا يجوز تعبد الله بغير الإسلام.
الأديان كلها باطلة إلا الإسلام:
لا دين يتسم بالمساوة بين البشر على أساس أنهم من أب واحد وأم واحدة كما يتسم الإسلام، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الناس لآدم وحواء، كطف الصاع لم يملئوه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} سورة الحجرات، آية: 13) رواه البيهقي وقال الألباني صحيح، ولا دين يتسم بالشمول كما يتسم الإسلام، عن سلمان رضي الله عنه قال: «قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل» رواه مسلم؛ ولا دين يتسم بقداسة نصوصه، وبُعدها عن التعرض للتعديل بالزيادة أو النقص أو التبديل، على مر الزمن، إلا دين الإسلام، قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} سورة الحجر، آية:9. بهذا القدر فقط من الحقيقة الإسلامية يمكن للعاقل أن يطلع على سائر أديان الأرض ويقارن، فسيجد العنصرية ماثلة في صورتها الفجة في الهندوسية التي تقسم الناس إلى طبقات أربعة، فأولها طبقة البراهمة الذين هم فوق القانون ولهم إبادة الجميع، وآخر هذه الطبقات طبقة المنبوذين الذين هم أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب قانون منو. (الأديان الشرقية، د/ سليمان العيد، ص32)، وكذلك تبرز العنصرية في اليهودية؛ حيث تقوم على أساس أن بني إسرائيل هم شعب الله المختار، وسائر الشعوب مخلوقون فقط ليكونوا عبيداً لهم!!، جاء في سفر التثنية: “لأنك شعب مقدَّس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض”. وحين تقارن بين شمولية الإسلام وما جاء في سائر الأديان، تدرك أن أدياناً كالهندوسية والكونفوشيوسية والبوذية والنصرانية لا علاقة لها بالتشريع، وتنظيم شؤون الحياة، وأنها مجرد دعوات روحية، تشتمل على قصص وأساطير ومعارك حربية وفي بعضها ترانيم تمجد الإله، وإذا كان في اليهودية تشريع، فإنه تشريع عنصري، شديد العنصرية ضد المرأة، فالمرأة في سفر الخروج تُبَاع وَتُشْتَرى: «وإذا باع رجل ابنته أمة، لا تخرج كما يخرج العبيد» وفي سفر اللاويين «إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام، ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا في دم تطهيرها، وإن ولدت أنثى، تكون نجسة أسبوعين، ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها»!!.
جوهر المسألة
ثم إن جوهر المسألة في قضية قداسة كتب الديانات السماوية السابقة على الإسلام، أنك حين تقرأ شيئاً منها لا تجد أن المتكلم فيها هو الله تعالى، ولا حتى موسى وعيسى؛ ففي أسفار موسى عليه السلام هناك طرف مجهول هو الذي يروي الأحداث، ليس هو موسى عليه السلام، لأنه مستمر في الرواية حتى بعد وفاة موسى عليه السلام، هذا المجهول لم يعرفه أحد حتى الآن، فإذا كانت الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم هي ما نزل على موسى عليه السلام؛ فكيف استمر الحديث فيها عن وفاة موسى وعن أحداث أخرى حصلت لبني إسرائيل من بعده، ليبقى اللغز: من كتب هذه الأسفار؟!، لذلك يقول وِل ديورَانت في قصة الحضارة ج2، ص367: «كيف كتبت هذه الأسفار؟ ومتى كتبت؟ وأين كتبت؟ ذلك سؤال بريء لا ضير منه، ولكنه سؤال كتب فيه خمسون ألف مجلد، ويجب أن نفرغ منه هنا في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب».
وفي العهدين القديم والجديد (التوراة والإنجيل) تجد عناية فائقة بحكاية الأحداث، ورواية التفاصيل، ناهيك عن كم التناقض بين أناجيل النصارى الأربعة، وكم التحريف الذي ما فتئوا يمارسونه حتى في عصرنا هذا، وإنما جرأ قلوبهم عليه أن النصوص الأصلية للتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، لا وجود لهما، ولا أصل لما بأيديهم منهما من الناحية التاريخية والعلمية البحتة، فلا يعدو العهد القديم أن يكون روايات شفوية جمعت من أفواه بني إسرائيل، أما الإنجيل برواياته الأربعة وتناقضاتها، فلو سلمنا جدلاً بأنها من كتابة من نسبت إليهم مرقس ومتى ولوقا ويوحنا، فإن المعروف هو ما صرح به وِل ديورَانت، ج11، ص207 حين قال: «وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث»، أي بعد رفع المسيح بثلاثة قرون، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن هذه الأناجيل لم تكتب قط باللغة الآرامية وهي لغة المسيح عليه السلام، ولا حتى بالعبرية، إنما كتبت باليونانية. يتبع.




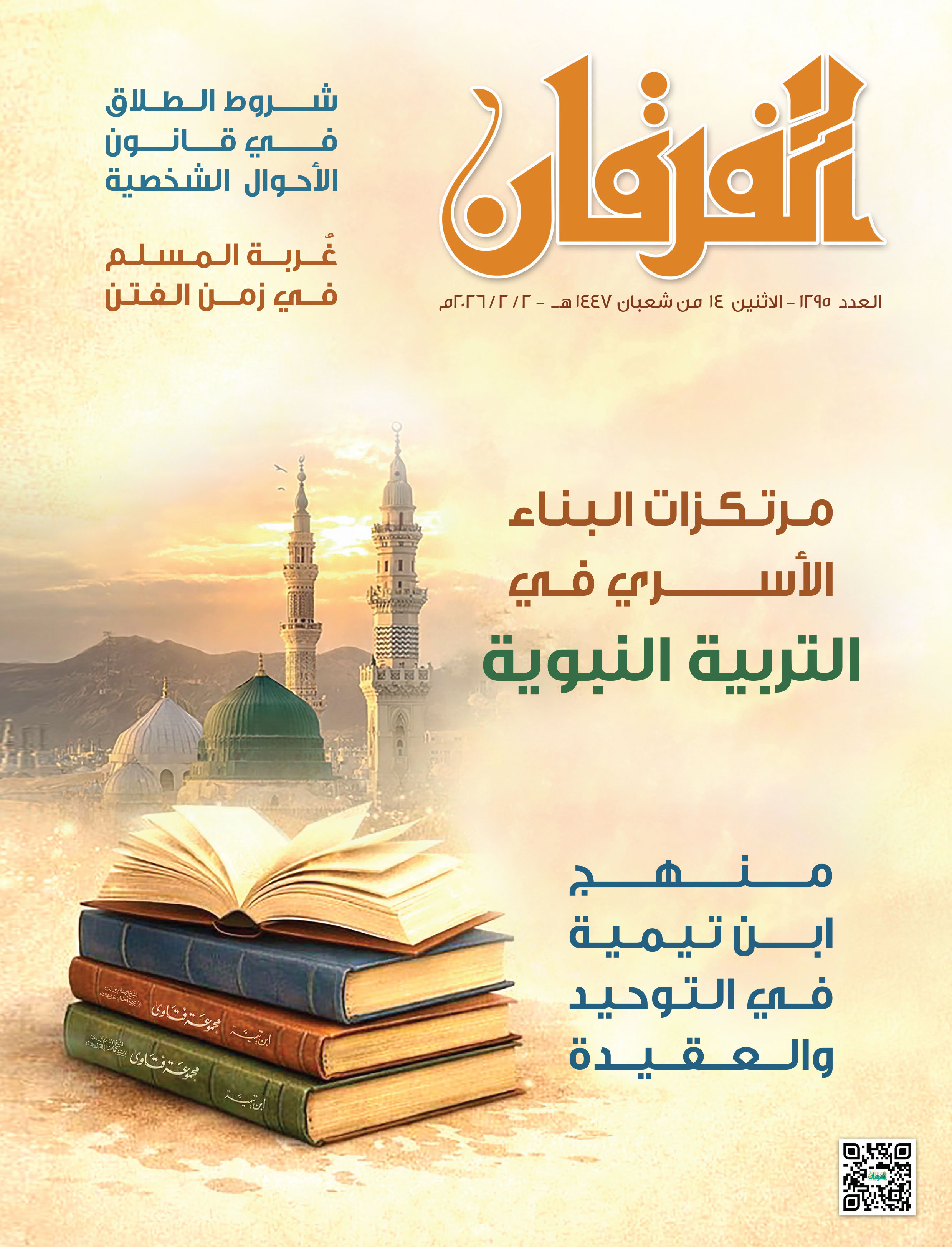







لاتوجد تعليقات