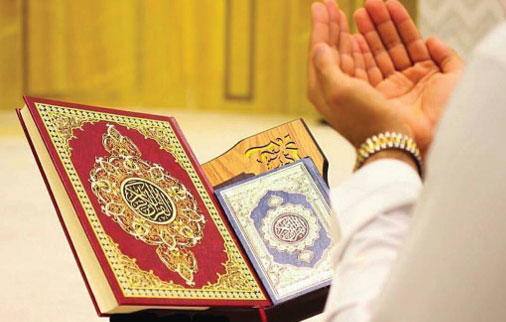
من حِكَمْ الاعتكاف ومقاصده
- المعتكف يلتمس ليلة القدر وشهودها في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد حتى يكون على خير حال يرضاها الله ورسوله
- من مقاصد الاعتكاف الخلوة مع النفس ومحاسبتها وإصلاحها وتهذيبها والتوبة من سوء فعالها ففي النفس أمراض لا يذهبها إلا الخلوة مع الله
يعيش المرء في زحام هذه الحياة حتى إنه من شدة ما يجد فيها من اللهو واللعب والمشاغل يكاد ينسى الغاية التي خلقه الله -تعالى- لأجلها؛ حيث قال الله -جل في علاه-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}(الذاريات: 56)؛ لكن من عظيم رحمة الله وفضله على عباده أن شرع لهم في دينه القويم وصراطه المستقيم ما يذكرهم بهذه الغاية العظيمة، بل وأكرمهم بمواسم يتعرضون فيها إلى النفحات الإيمانية واختصهم كذلك بعبادات ينالون بها الكرائم الربانية.
ألا وإن من هذه العبادات الجليلة عبادة الاعتكاف ولزوم المساجد خصوصا في العشر الأخيرة من رمضان، ونقول أن من جاز له الاعتكاف وصار في حقه مسنونا ينبغي عليه أن يراعي أمورا مهمة في الاعتكاف وغاياته وحكمه؛ لأن من الناس من يكره في حقه الاعتكاف لحاجة أهله له أو الديه أو أولاده أو غير ذلك، وإليكم إشارات سريعة متعلقة بمقاصد الاعتكاف وحِكَمه:الخلوة مع الله والتبتل إليه
قال الله: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}(المزمل: 8)، والتبتل: يعني الانقطاع عن الدنيا إلى الله، قال البغوي في تفسير قوله -تعالى-: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}؛ أي: «انقطع إليه في العبادة انقطاعًا وهو الأصل في الباب، يقال: تبتلت الشيء أي: قطعته، وهو رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله، ويقصد به كذلك: تفرّغ البال والفكر إلى ما يرضي الله؛ فكأنّ الفرد انقطع عن النّاس، وانحاز إلى جانب الله، والتبتل يجمع أمرين: الانفصال والاتصال؛ فالانفصال: هو انقطاع القلب عن حظوظ النفس التي تزاحم مراد الرب، وعن التفات القلب إلى ما سوى الله، والاتصال، وهو اتصال القلب بالله -تعالى- والإقبال عليه، وإقامة القلب على مراد الله.الخلوة مع النفس ومحاسبتها
الخلوة مع النفس ومحاسبتها وإصلاحها وتهذيبها والتوبة من سوء فعالها، {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}(الشمس: 9-10)، فقد كان السلف الصالح يعكفون في هذه الأيام المباركة يحاسبون أنفسهم وينقونها من الذنوب والمعاصي، وفي النفس أمراض وبلاء لا يذهبها إلا الخلوة مع الله والانعزال بالنفس لمعرفة أمراضها وعلاجها منه.التماس ليلة القدر
التماس ليلة القدر التي حازت الفضائل الكثيرة والمزايا العظيمة، وشهودها في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد وإدراك المسلم لها وهو على حال يرضاها الله ورسوله؛ {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}(القدر: 3- 5).التخفف من خلطة الناس
الاعتكاف وسيلة للتخفيف من خلطة الناس عموما وتخفيف الانشغال بالأهل والأولاد، قال ابن رجب: «وإنما كان يعتكف النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا العشر التي يطلب فيها ليلة القدر؛ قطعاً لإشغاله وتفريغا للياليه وتخلياً لمناجاة ربه وذكره ودعائه وكان يحتجر حصيرًا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم»، ولهذا ذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، «إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات؛ فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد في شهر رمضان خصوصا في العشر الأواخر منه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه.الانعزال عن الدنيا وشهواتها
الانعزال عن الدنيا وشهواتها ومتاعها والانشغال بالتجارة والمرابحة والوظائف وغيرها؛ {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}(الكهف: 28).السادسة: التفرغ للذكر والدعاء
الهدف من الاعتكاف التفرغ للعبادة كالذكر والدعاء والقيام وقراءة القرآن، {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}(الشرح: 7- 8)؛ لا كما يصنع بعض المعتكفين -هداهم الله- حيث يقضون نهارهم في النوم وتصفح الشبكة العنكبوتية وبرامج التواصل الاجتماعي (كالواتس والسناب وتويتر وفيسبوك) ويضيعون ليلهم باستقبال الزيارات والجلسات الاجتماعية وربما صاحبت القيل والقال والزور -والعياذ بالله- وهؤلاء في الحقيقة لم يراعوا مقاصد الاعتكاف الشرعي ولم يبلغوا حقيقته وإن سمي صنيعهم عند أهل اللغة اعتكافا.فرصة لمراجعة القرآن الكريم
الاعتكاف فرصة لمراجعة القرآن الكريم ومدارسته، ولا شك أن مراجعة القرآن وحفظه وإتقانه ومدارسته من أجل القربات، ويدل على ذلك نزول جبريل -عليه السلام- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لتدارس القرآن، عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-، «أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان من أجودِ الناسِ وأجودَ ما يكونُ في رمضانَ حين يلقاهُ جبريلُ يلقاهُ كلَّ ليلةٍ يُدارِسُهُ القرآنَ».تعويد النفس على التعلق بالمساجد
تعويد النفس على ارتياد المسجد والتعلق بها والأنس بمرتاديها، وقد بشر النبي - صلى الله عليه وسلم - بثواب المعلقة بقلوبهم بالمساجد حين ذكر السبعة اللذين يظلهم الله في ظله ومنهم: «ورجلٌ قلبُه مُعلَّقٌ في المساجدِ»، وفي روايةٍ: «ورجلٌ مُعلَّقٌ بالمسجدِ، إذا خرج منه حتى يعودَ إليه» (رواه البخاري ومسلم)، ولا شك أن تعلق القلب بالمسجد سمة أهل الإيمان بخلاف أهل النفاق وضعاف الإيمان يتضايقون من المساجد والمكث فيها؛ فتجدهم آخر الناس دخولا لها وأولهم خروجا منها وأكثرهم رغبة عنها وهذا من الحرمان، والله المستعان.لم شعث القلب وإصلاحه
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله -تعالى-، متوقفاً على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله -تعالى- فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله -تعالى-، وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله -تعالى-، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله -تعالى-، وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة.اكتساب الأجور العظيمة
من أبواب الأجور العظيمة البقاء في المساجد بنية القربى منه -سبحانه وتعالى- {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}(العلق: 19)، أو لأجل انتظار الصلاة؛ ناهيك عن أجور الطاعات الأخرى إذا مارسها؛ كصلاة وقراءة للقرآن وذكر ومدارسة وحضور مجلس علم وغيرها.إحياء سنة المصطفى القولية والفعلية
فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر حتى لقي ربه، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها-، «أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكفَ أوَّلَ سنةٍ العشرَ الأولَ ثمَّ اعتكفَ العشرَ الوسطى ثمَّ اعتكفَ العشرَ الأواخرَ وقالَ إنِّي رأيتُ ليلةَ القدرِ فيها فأنسيتُها فلم يزل رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يعتكفُ فيهنَّ حتَّى توفِّيَ - صلى الله عليه وسلم .ختام رمضان عبرة وعظة
- صدَرَ قرارُ هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنها عبادةٌ وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنها تخرج طعاما
- شرَعَ اللهُ لنا في ختام رمضان عباداتٍ جليلةٍ نزدادُ بها إيمانًا وتكمُل بها عباداتُنا وتَتمُّ بها علينا نعمةُ ربِّنا شرَعَ لنا ربُّنا زكاةَ الفطرِ وتكبيرَ ليلةِ العيد وصلاته
- علينا الانتباه لسُرْعةِ الأيام والحذرِ من الاغترارِ بالدنيا فمع سُرعة قُرب رحيل رمضان نتذكر وصيَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لابنِ عُمَر «كُنْ في الدُّنيا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابرُ سَبيلٍ»
- الصوم له أثر عظيم في صلاح أخلاق المسلم وتربيته وترويضه على النافع منها دون الضار والحسن دون القبيح
- أبرز علاماتِ القَبُول هو استمرارُكَ على العمل الصالح بعد انقضاءِ رمضان فمن عمل حَسَنةً ثم أتبعها بحسنةٍ بعدَها كان ذلكَ علامة على قبول الحسنة الأولى
- عليك أن تجمع بين الإحسان والخوف فلا تـْغـَتـَّر بما قدمته من عمل مـن المحافظة على صـلاة التراويح وتفطير الصائمين وغير ذلــك فالصحابة لا يـعجـُبون بعملهم ولا يفتنون بثناء الناس عليهم
هذا شهرُ رمضانَ قد تقاربَ تَمامُه، وتصرَّمت لياليه الفاضلةُ وأيَّامُه، فمن كان منكم مُحسناً فيه فعليه بالإكمال والإتمام، ومَن كان مُقصِّراً فليختمه بالتوبة والاستدراك، فالعمل بالختام، واستَمِرُّوا في التماسِ ليلةِ القدرِ، التي قال - صلى الله عليه وسلم - عنها: «مَن قامَ ليلَةَ القَدْرِ إيماناً واحتِساباً غُفِرَ لهُ ما تقَدَّمَ من ذنبهِ»، وعليك أيها المؤمنُ أن تزيد في عبادتكَ وتَحُثَّ أهلَكَ وتُنشِّطُهم وتُرغِّبهم في العبادةِ لا سيَّما في هذه الأربع الأواخر التي لا يُفرِّط فيها إلا محروم، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» رواه مسلم.
وقد بلغَ مجموعُ الروايات التي حدَّدت ليلة القدر بليلةِ سبعٍ وعشرين من خلال الكتب التسعة إلى سبع رواياتٍ، وأربعُ رواياتٍ في تحديدها بصفةٍ تنطبقُ على أواخرِ الشهر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تَحَرَّوْها ليلَةَ سَبْعٍ وعشرِينَ» رواه الإمام أحمد، وعن أُبيِّ بن كعب - رضي الله عنه -: «وواللهِ إني لأَعلَمُ أيُّ ليلةٍ هيَ، هيَ الليلَةُ التي أمَرَنَا بها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقيامِهَا، هيَ ليلَةُ صَبيحَةِ سَبْعٍ وعشرينَ، وأَمَارَتُهَا أنْ تَطْلُعَ الشمسُ في صَبيحَةِ يوْمِهَا بيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَها»، فعليكَ أخي المسلم أن تَحْرِصَ على تحقيق هذا الخير، والحصول عليه بالعبادة والطاعة فيما بقي من هذه الليالي من الصلاة والتلاوة والذكر والدُّعاء، وكلِّ ما تستطيعُه من الباقيات الصالحات.
عبادات جليلة
لقد شرَعَ اللهُ لنا في ختام شهرنا عباداتٍ جليلةٍ، نزدادُ بها إيماناً، وتكمُل بها عباداتُنا، وتَتمُّ بها علينا نعمةُ ربِّنا، شرَعَ لنا ربُّنا زكاةَ الفطرِ، وتكبيرَ ليلةِ العيدِ، وصلاةَ العيدِ.زكاةُ الفطر
عنِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قالَ: «فَرَضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكَاةَ الفِطْرِ صاعاً مِن تَمْرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ، علَى العبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمينَ، وأَمَرَ بها أنْ تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلى الصلاةِ»، وكان الصحابةُ -رضي الله عنهم- يُؤدُّونها قبلَ العيدِ بيومٍ أو يومينِ، قال نافعٌ -رحمه الله-: «وكانُوا يُعْطُونَ قبلَ الفِطْرِ بيومٍ أو يومينِ» رواه البخاري، وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: «إنَّ الذي تحرَّر لنا في مقدار الصاع النبويِّ أنه قدر أربع حَفَناتٍ بيديِّ الرَّجُلِ المعتدِلِ في الْخِلْقة»، وقالت أيضًا: «ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً» انتهى.طُهرة وطُعمة
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ منَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للمساكينِ، مَنْ أدَّاهَا قبلَ الصلاةِ فهِيَ زكاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أدَّاهَا بعدَ الصلاةِ فهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصدقَاتِ»، وقد صدَرَ قرارُ هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لأنها عبادةٌ، وقد بيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما تُخْرَجُ منه وهو الطعام، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: «وتُعطى فقراءَ المسلمين في بلدِ مُخرجها، ويجوزُ نقلها إلى فقراءِ بلدٍ أُخرى أهلُها أشدُّ حاجة» انتهى.التكبير عند إكمال العدَّة
ومما شرَعَ لنا ربُّنا في ختام شهرنا: التكبير عند إكمال العدَّة: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة: 185)، وعنِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- «أنهُ كانَ يُكبِّرُ إذا غَدَا إلى الْمُصَلَّى يومَ العِيدِ»، وعن أُمِّ عطيَّةَ -رضي الله عنها- قالت: «كُنَّا نُؤمَرُ أنْ نَخْرُجَ يومَ العيدِ حتى نُخْرِجَ البكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ الناسِ، فيُكَبِّرْنَ بتكبيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعائهِم، يَرْجُونَ بَركَةَ ذلكَ اليومِ وطُهْرَتَهُ» قال النووي: «يُستَحَبُّ رَفْعُ الصوتِ بالتكبيرِ بلا خِلافٍ».صلاة العيد
ومما شَرَعَ لنا ربُّنا في ختام شهرنا: صلاة العيد، فعن أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قالت: «أُمِرنا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ، وذوَاتِ الخُدُورِ، فيَشهَدنَ جماعةَ المسلمينَ ودَعْوَتَهُم، ويَعتزِلُ الحُيَّضُ عن مُصلاَّهُنَّ، قالتِ امرأةٌ: يا رسولَ اللهِ إحدانا ليسَ لَهَا جلبابٌ؟ قالَ: لِتُلْبسْهَا صاحِبَتُهَا من جِلْبَابهَا»، والجلبابُ: لباسٌ تلتحفُ فيه المرأةُ بمنزلةِ العَباءة، وليَخرُجِ الرِّجالُ متنظِّفين مُتطيِّبين لابسين أحسنَ ثيابهم، مع الحذر من الفخر والتكبُّرِ وإسبالِ الثيابِ والعَباءات، وليَخرُجِ النساءُ مُحتشماتٍ بالعباءاتِ الشرعيةِ غيرَ متطيِّباتٍ ولا مُتبرِّجاتٍ بزينة. والسنةُ أن يأكُلَ المسلمُ في بيته قبل الخروج إلى الْمُصلَّى تَمَراتٍ وِتْرَاً، فعن أنسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - قالَ: «كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُو يومَ الفِطْرِ حتى يأكُلَ تَمَرَاتٍ»، وقالَ مُرَجَّأُ بنُ رَجَاءٍ، حدَّثني عُبيدُ اللهِ، قالَ: حدَّثني أنسٌ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «ويَأْكُلُهُنَّ وِتْراً»«، وقال الشيخ ابن عثيمين: «وأمَّا الخروجُ بالتمرِ إلى مُصلَّى العيدِ وأكلُه هناكَ فليسَ بسُنَّةٍ بلْ هو بدعة» انتهى.من أحكام صلاة العيد
من أحكام صلاة العيد: ألاَّ أذانَ ولا إقامةَ لصلاةِ العيد، قال جابرٌ - رضي الله عنه -: «لا أذانَ للصلاةِ يومَ الفِطْرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شيءَ، لا نِداءَ يومَئِذٍ ولا إقامةَ» رواه مسلم. ويُستحبُّ الاغتسالُ لصلاة العيد: قال سعيدُ بن المسيَّب: «سُنةُ الفطرِ ثلاثٌ: المشيُ إلى المصلَّى، والأكلُ قبلَ الخُروجِ، والاغتسالُ» صحَّحه الألباني. وكذا يُستحبُّ التجمُّل في العيد باللباس الْحَسَن، وكذا يُستحبُّ التطيُّب للعيد: سُئل نافعٌ -رحمه الله-: «كيفَ كانَ ابنُ عُمَرَ يَصنَعُ يومَ العيدِ؟ قالَ: كانَ يَشْهَدُ صلاةَ الفجرِ معَ الإمامِ ثُمَّ يَرجِعُ إلى بيتِهِ فيَغتَسِلُ غُسْلَهُ منَ الجَنابةِ، ويَلْبَسُ أحسَنَ ثِيابهِ، ويَتَطَيَّبُ بأطيَبِ ما عِنْدَهُ، ثُمَّ يَخرُجُ حتى يأتيَ الْمُصَلَّى».التهنئةُ بالعيد
وأمَّا التهنئةُ بالعيد: فعن جُبيرِ بنِ نُفَيْرٍ قالَ: «كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا التَقَوْا يومَ العِيدِ يقُولُ بعضُهُم لبعضٍ: تقَبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنْكَ»، وليحذر المسلم من تخصيص ليلة العيد بقيامٍ من بين سائر الليالي: قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: «تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سُنةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -» انتهى.
مع انقضاء رمضان عبرة وعظة
مع قرب رحيل رمضانَ ينبغي علينا أن نتدبَّرَ ونتفكَّرَ في أمور عدة أهمها ما يلي:أولاً: عدم الاغترار بالدنيا
علينا الانتباه لسُرْعةِ الأيام والحذرِ من الاغترارِ بالدنيا، فمع سُرعة قُرب رحيل رمضان تتذكر وصيَّةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لابنِ عُمَرَ، فعَنْ عبداللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قالَ: أَخَذَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكِبي فقَالَ: «كُنْ في الدُّنيا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابرُ سَبيلٍ»، وكانَ ابنُ عُمَرَ يقُولُ: «إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»» رواه البخاري، فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوصي شابَّاً في العشرينَ من عُمُرِه بقِصَرِ الأَمَلِ والحذرِ من الدُّنيا، فتذكَّر بقُربِ رحيلِ رمضان: خواتيمَ الأعمالِ، وخواتيمَ الأعمارِ، والاستعدادِ للسَّفَرِ الطويل.
ثانيًا: الجمع بين الإحسانِ والخوفِ
عليك أيها المسلم أنْ تجمعَ بين الإحسانِ والخوفِ، فلا تَغْتَرَّ بما قدَّمْتَهُ من عَمَلٍ، منَ المحافظةِ على صلاةِ التراويحِ وتفطيرِ الصائمينَ وغيرِ ذلك، فالصحابةُ لا يُعْجَبُون بعَمَلِهِم، ولا يُفتنونَ بثناءِ الناسِ، قال ابنُ القيِّم: «فإنَّ اللهَ إذا أراد بعبدٍ خيراً سَلَبَ رُؤيةَ أعمالِهِ الْحَسَنةِ من قَلْبهِ، والإخبارِ بها من لسانهِ، وشَغَلَهُ برُؤيةِ ذنبه، فلا يزال نُصْبَ عينيهِ حتى يَدْخُلَ الجنَّةَ، فإنَّ ما تُقُبِّلَ من الأعمالِ رُفِعَ من القلبِ رُؤيتُهُ، ومن اللسانِ ذِكْرُه»، وقد بيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن العبدَ العاقلَ لا يرتكنُ إلى عَمَلِهِ الذي لا يَدْرِي أقبلَهُ اللهُ منهُ أم لا، فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: «سَدِّدُوا وقَارِبُوا وأَبْشِرُوا، فإنهُ لا يُدْخِلُ أَحَداً الجنَّةَ عَمَلُهُ، قالُوا: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ولا أنا، إلاَّ أنْ يَتَغَمَّدَني اللهُ بمغْفِرَةٍ ورَحْمَةٍ» رواه البخاري ومسلم. وعنْ عائشةَ قالتْ: قُلْتُ يا رسولَ اللهِ: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} (المؤمنون: 60)، أَهُوَ الرَّجُلُ يَزْني ويَسْرِقُ ويَشْرَبُ الخَمْرَ؟ قالَ: لا يا بنْتَ أبي بكْرٍ - أوْ: لا يا بنْتَ الصِّدِّيقِ - ولكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ ويُصَلِّي ويَتَصَدَّقُ، وهُوَ يَخافُ أنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُ»، فأُمُّ المؤمنين تظنُّ أن الخائفَ هو مَن أتى بالموبقات، ومثلُه يَحقُّ له الخوف، فصحَّحَ لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ الصادقَ هو من يجمع مع الإحسان خوف عدم القبول.تواضع الصحابةِ -رضي الله عنهم-
وإليكَ هذا المثال من تواضع الصحابةِ -رضي الله عنهم-: ففي حديث قصَّةِ استشهادِ ثاني الخلفاءِ الراشدين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال عمروُ بنُ ميمون: «فاحْتُمِلَ إلى بَيْتِهِ فانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وكأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصيبَةٌ قبلَ يوْمَئِذٍ، فقَائِلٌ يقولُ: لا بأْسَ، وقائلٌ يقولُ: أَخَافُ عليهِ، فأُتِيَ بنَبيذٍ فشَرِبَهُ، فخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتيَ بلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فعَلِمُوا أنهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عليهِ، وجَاءَ الناسُ، فجَعَلُوا يُثْنُونَ عليهِ، وجاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فقالَ: أَبْشِرْ يا أميرَ المؤمنينَ ببُشْرَى اللهِ لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقَدَمٍ في الإسلامِ ما قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فعَدَلْتَ، ثمَّ شَهَادَةٌ، قالَ: وَدِدْتُ أنَّ ذلكَ كَفَافٌ لا علَيَّ ولا لِي»، قال ابن حجر: «وما أَحْسَنَ قَوْلَ أبي عُثمانَ الجِيزِيِّ: «مِنْ علامةِ السعادةِ أنْ تُطِيعَ وتَخافَ أنْ لا تُقْبَلَ، ومِنْ علامةِ الشَّقاءِ أنْ تَعْصِيَ وترجو أنْ تنجو»».ثالثاً: أبرزَ علاماتِ القَبُول
إنَّ أبرزَ علاماتِ القَبُول هو استمرارُكَ على العمل الصالح بعد انقضاءِ رمضان، فمن عمل حَسَنةً ثم أتبعها بحسنةٍ بعدَها كان ذلكَ علامة على قبول الحسنة الأولى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أحَبَّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْوَمُهَا وإنْ قَلَّ» رواه البخاري ومسلم.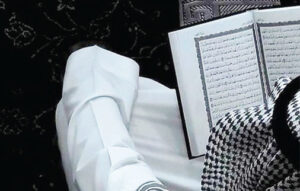
بماذا تَختم رمضان
أمَرَ اللهُ عبادَهُ أن يختموا أعمالهم العظيمة بالاستغفار، «عنْ ثوْبانَ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا انْصَرَفَ مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثاً»، وقال تعالى فيما يَفعلُ الحاجُّ بعد نُزوله من عرفة: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، وأمَرَ اللهُ نبيَّنا - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَختمَ حياتَهُ بالاستغفار، «عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ مِن قَوْلِ: سُبحانَ اللهِ وبحمْدِهِ، أَستَغْفِرُ اللهَ وأتُوبُ إليهِ، قالتْ: فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ، أَرَاكَ تُكثِرُ مِن قولِ: سُبْحَانَ اللهِ وبحمدِهِ، أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ؟ فقالَ: خَبَّرَني رَبِّي أنِّي سَأَرَى عَلامَةً في أُمَّتي، فإذا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِن قولِ: سُبْحَانَ اللهِ وبحمدِهِ، أســتـغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقدْ رأَيْتُها: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}، فَتْحُ مَكَّةَ، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} (النصر: 1- 3)» رواه مسلم، وإن العبدَ ليتحسَّرُ على تفريطهِ، فبالأمسِ نستقبلُ رمضان، وبعدَ عدة أيام سيُودِّعُهُ الحيُّ منَّا، فسبحانَ مَنْ قلَّبَ الليل والنهار، وفي ذلك مُعتبرٌ للمُعْتَبرِين.



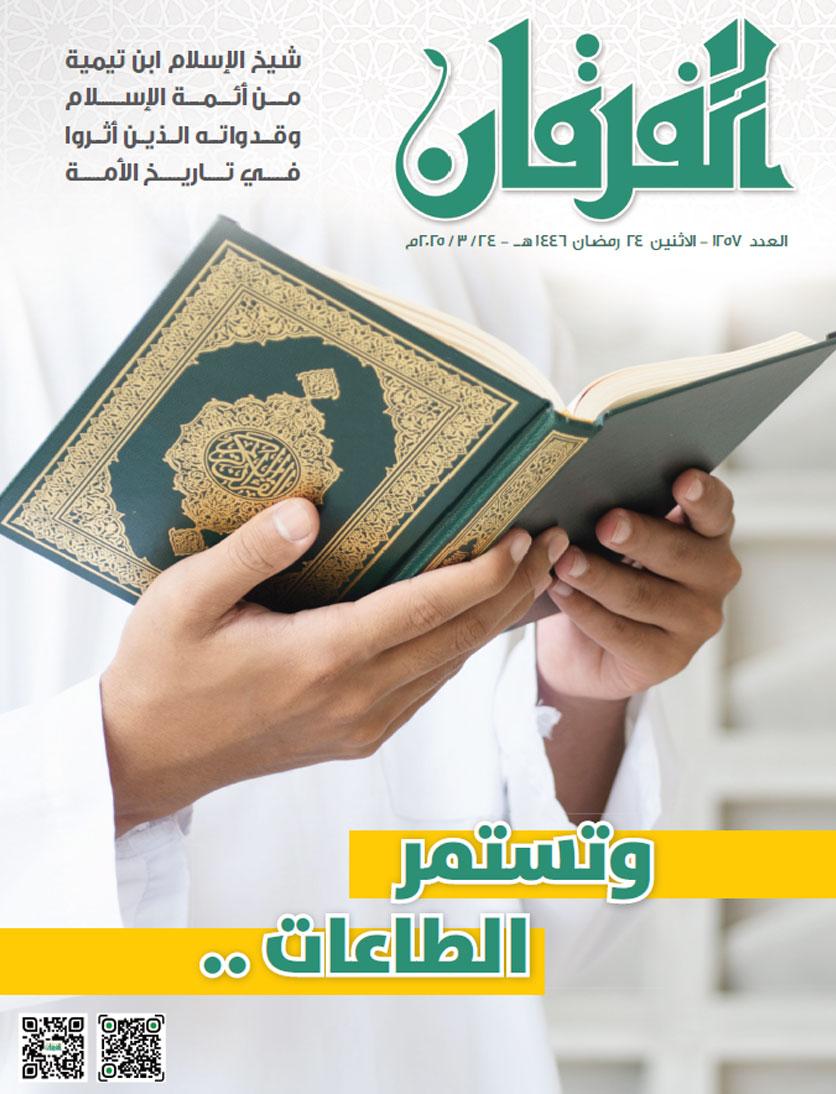







لاتوجد تعليقات