
رسالة في الطريق إلى ثقافتنا (1)
في وقتٍ يحاول فيه بعض الناس أن يقْصِر معنى المثقَّف على مَن اشتغل بالآداب والفنون، بل على أنواعٍ معينةٍ فيها، يجدر بنا أن نتساءل: هل هذه هي ثقافتنا؟! وإذا لم تكن فما ثقافتنا؟! وما الذي حال بيننا وبينها؟! وما السبيل للعودة إليها؟!
سيكون مِن المفيد جدًّا أن نجدَ إجابات شافية عن هذه الأسئلة، ولاسيما إذا جاءت ممَن يقرُّ له هؤلاء المثقفون بالريادة الثقافية؛ فلا يشك منهم أحدٌ أنه فارس في ميدان النقد الأدبي، كانت له مع كبارهم صولات وجولات، وعجز أسلافهم عن مجاراته في التمكُّن مِن العربية؛ ولاسيما جانب التذوق، الذي صكَّ فيه نظرية طبَّقها في كتاباته، ولاسيما كتابه عن (المتنبي)، وأشار في مقدمته إليها إشاراتٍ عابرة ثم فصَّلها في كتابٍ ذائع الصيت هو: (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا)، إنه العلامة محمود محمد شاكر.
الغرض مِن الكتاب
كان الغرض مِن هذا الكتاب أن يَشرح الأستاذ نظريته في التذوق، ولكن مرارة (مدعي الثقافة) غلبت على مذاق اللغة الجميلة في نفسه وروحه؛ فأخرج كتابه هذا نفثة مهموم، وتأوه مكلوم، وصيحة تحذير مِن الثقافة الوافدة، وهنا ترك لقلمه العنان لكي يلَخِّص لك قرونًا مِن الصراع بيْن الحق والباطل؛ مما جعل بحثه يخرج عن نطاق فلسفة اللغة إلى فلسفة التاريخ، ورغم لذة التطواف معه في دروب عقله، إلا أن هذا ربما يمنع كثيرًا مِن القراء مِن الإحاطة بفوائده؛ ولذلك فسوف نقدِّم اختصارًا وترتيبًا لأهم فوائد هذا الكتاب، التي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
• أولًا: تعريف الثقافة، وموضع اللغة والدين والأخلاق منها.
• ثانيًا: الاستشراق، وكيف بدأ بالنهل مِن ثقافتنا، ثم صار حربًا عليها!
• ثالثًا: الصراع بيْن النهضتين: (الإسلامية، والأوروبية) في القرن السابع عشر الميلادي.
• رابعًا: الحملة الفرنسية على مصر، وسياسة تدجين أهل الدِّين في بلادنا.
• خامسًا: التغريب في الثقافة والتعليم في عهد الاحتلالين: (الفرنسي، والإنجليزي).
تعريف الثقافة
تعرض الأستاذ محمود شاكر في أكثر مِن موضعٍ في رسالته لتعريف (الثقافة) وعلاقتها بـاللغة التي يَرى أنها الوعاء الجامع للثقافة، وكذلك علاقتها بـ(الدين) الذي يرى أنه يمثِّل قمة الهَرَم المعرفي لكل أُمَّة؛ فقال: الثقافة في جوهرها لفظٌ جامِع، يُقصد بها الدلالة على شيئين أحدهما مبني على الآخر، أي هما طوران متكاملان.
الطور الأول
أصول ثابتة مكتسَبة تنغرس في نفْس الإنسان منذ مولده ونشأته الأولى حتى يشارف حدَّ الإدراك البيِّن، جِماعها كل ما يتلقاه عن أبويه وأهله وعشيرته، ومعلِّميه ومؤدِّبيه، حتى يصبح قادرًا على أن يستقل بنفسه وبعقله، وتفاصيل ما يتلقاه الوليد حتى يترعرع، أو يراهق تفوت كل حصر، بل تعجزه.
ضرورة لازمة
وهذه الأصول ضرورة لازمة لكل حيٍّ ناشئ في مجتمعٍ ما، لكي تكون له لغة يبين بها عن نفسه، ومعرفة تتيح له قسطًا مِن التفكير يعينه على معاشرة مَن نشأ بينهم مِن أهله وعشيرته، وهذا على شدة وضوحه عند النظرة الأولى؛ لأنك أَلِفْته، لا لأنك فكرت فيه وعمَّقت التفكير، هو في حقيقته سِرٌّ مُلَثـَّمٌ يحيِّر العقولَ إدراكُ دفينِه؛ لأنه مرتبط أشد الارتباط، بل متغلغل في أعماق سرَّين عظيمين غامضين هما: سر النطق، وسر العقل، اللذان تميَّز بهما الإنسان عِن سائر الخَلْق كله، وتحيرت عقول البشر في كيف جاءا؟ وكيف يعملان؟؛ لأن الإنسان لم يشهد خَلْق نفسه حتى يستطيع أن يستدل بما شهد لكي يصل إلى حقيقة هذين السرَّين المُلَثَّمَين المستغلقين البعيدين، وإن تَوَهَّم أحيانًا بالإلف أنهما قريبان واضحان!
فطرة باطنة
ولأن الإنسان منذ مولده قد استودع فطرة باطنة بعيدة الغور في أعماقه تُوزِعه -أي تُلْهِمه وتحركه- أن يتوجَّه إلى عبادة ربٍّ يُدرِك إدراكًا مبهمًا أنه خالقه وحافظه ومعينه؛ فهو لذلك سريع الاستجابة لكل ما يلبي حاجة هذه الفطرة الخفية الكامنة في أغواره، وكل ما يلبي هذه الحاجة هو الذي هدى الله عباده أن يسموه: الدِّين، ولا سبيل البتّة إلى أن يكون شيء مِن ذلك واضحًا في عقل الإنسان، إلا عن طريق اللغة لا غير؛ لأن العقل لا يستطيع أن يعمل شيئًا فيما نعلم إلا عن طريق اللغة؛ فالدِّين واللغة منذ النشأة الأولى متداخلان تداخلًا غير قابلٍ للفصل، ومَن أغفل هذه الحقيقة ضلَّ الطريق وأوغل في طريق الأوهام، هذا شأن كل البشر على اختلاف مِلَلِهم وألوانهم، لا تكاد تجد أُمَّة مِن خلق الله ليس لها دين بمعناه العام، كتابيًّا كان، أو وثنيًّا، أو بِدْعًا(البِدْعُ: الدين ليس له كتاب، أو وَثَن معبود).
الوليد الناشئ
ولذلك؛ فكل ما يتلقّاه الوليد الناشئ في مجتمعٍ ما، مِن طريق أبويه وأهله وعشيرته، ومعلِّميه، ومؤدِّبيه مِن لغة ومعرفة، يمتزج امتزاجًا واحدًا في إناءٍ واحدٍ، ركيزته، أو نواته، وخميرته دِين أبويه ولُغَتهما، وأبلغهما أثرًا هو الدين؛ فالوليد في نشأته يكون كل ما هو لغة، أو معرفة، أو دين، متقبَّلًا في نفسه تَقَبُّل الدِّين، أي يتلقاه بالطاعة والتسليم، والاعتقاد الجازم بصحته وسلامته، وهذا بيِّنٌ جدًّا إذا أنتَ دقّقت النظر في الأسلوب الذي يتلقّى به أطفالُك عنك ما يسمعونه منك، أو مِن المعلّم في المراحل الأولى مِن التعليم، ويظل حال الناشئ يتدرج على ذلك، لا يكاد يتفصّى شيءٌ مِن مَعارِفه من شيءٍ -يتفصّى: أي يتخلص مِن هذا المضيق- حتى يقارب حد الإدراك والاستبانة، ولكنه لا يكاد يبلغ هذا الحد حتى تكون لغته ومعارفه جميعًا قد غُمست في الدين وصُبغت به.
شمول الدين
وعلى قدر شمول الدين لشؤون حياة الإنسان، وعلى قدر ما يحصل مِن الناشئ، يكون أثره بالغ العمق في لغته التي يفكر بها، وفي معارفه التي ينبني عليها كل ما يوجبه عمل العقل مِن التفكير والنظر والاستدلال؛ فهذه هي الأصول الثابتة المكتسبة في زمن النشأة على وجه الاختصار.
الطور الثاني
فروع منبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة، وهي تنبثق حين يخرج الناشئ مِن إسار التخسير إلى طلاقة التفكير، وإنما سميتُ (الطور الأول): (إسار التخسير)؛ لأنه طَورٌ لا انفكاك لأحدٍ مِن البشر منه منذ نشأته في مجتمعه؛ فإذا بلغ مبلغ الرجال استوت مَدارِكه، وبدأت مَعارِفه يتفصّى بعضها من بعض، أو يتداخل بعضها في بعض، ويبدأ العقل عمله المستتب في الاستقلال بنفسه، ويستبد بتقليب النظر والمُبَاحَثة وممارسة التفكير والتنقيب والفصح، ومعالجة التعبير عن الرأي الذي هو نتاج مزاولة العقل لعمله؛ فعندئذٍ تكون النواة الجديدة لما يمكن أن يُسمى ثقافة.
اللغة والمعارف
وبيِّنٌ أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو اللغة والمعارف الأُول التي كانت في طورها الأوَّل، مصبوغة بصبغة الدين لا محالة، حتى لو استعملها في الخروج على الدين الموروث ومناقشته رفضًا له أو لبعض تفاصيله، هذه حال النشء الصغار حتى يبلغوا منزلة الإدراك المستقل المفضي إلى حيز الثقافة.
ثقافة كل أمة
وثقافة كل أمة وكل لغة، هي حصيلة أبنائها المثقفين بقدرٍ مشتركٍ مِن أصول وفروع، كلها مغموس في الدين المتلقَّى عند النشأة؛ فهو لذلك صاحب السلطان المطلق الخفي على اللغة، وعلى النفس، وعلى العقل جميعًا، سلطان لا ينكره إلا مَن لا يبالي بالتفكر في المنابع الأول التي تجعل الإنسان ناطقًا وعاقلاً ومُبينًا عن نفسه، ومستبينًا عن غيره.
موضع الدين مِن الثقافة
ويتحدث في موطنٍ آخر عن موضع الدين مِن الثقافة، ثم يدلف منه إلى موقع الأخلاق منها؛ فيقول: ورأس كل ثقافة هو الدِّين بمعناه العام الذي هو فطرة الإنسان، أيّ دين كان، أو ما كان في معنى الدين، وبقدر شمول هذا الدين لجميع ما يكبح جموح النفس الإنسانية، ويحجزها عن أن تزيغ عن الفطرة السوية العادلة، وبقدر تغلغله إلى أغوار النفس الإنسانية تغلغلًا، يجعل صاحبها قادرًا على ضبط الأهواء الجائرة ومريدًا لهذا الضبط، بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيان الإنسان، تكون قوة العواصم التي تعصم صاحبها مِن كل عيبٍ قادحٍ في مسيرة ما قبْل المنهج، ثم في مسيرة المنهج الذي ينشعب مِن شطره الثاني، وهو شطر التطبيق.
شأن كل جيل
وهذا الذي حدثتك عنه، ليس خاصًّا بأُمَّة، بل هو شأن كل جيل من الناس وكل أمة من الأمم كان لها لغة، وكان لها ثقافة، وكان لها بعد تمام ذلك حضارة مؤسَّسة على لغتها وثقافتها؛ فهذا الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يمكن لثقافة الأمة بمعناها الشامل أن تبقى متماسكةً مترابطةً، تزداد على مرِّ الأيام تماسكًا وترابطًا بقدر ما يكون في هذا الأصل الأخلاقي مِن الوضوح والشمول، والتغلغل والسيطرة على نفوس أهلها جميعًا.
أثر الأخلاق الإسلامية
ثم ذكر مبيِّنًا أثر الأخلاق الإسلامية في نشأة كثيرٍ مِن العلوم الإسلامية، ولاسيما المتعلقة بعلوم القرآن والسُّنَّة، وكيف بني ذلك على قواعد التثبت في الأخبار، وكذلك التأصيل لمسألة ارتباط العلم بالآداب التي ألحَّ عليها الكثير ممَن صنَّفوا في آداب طالب العلم؛ فقال: كان ينبغي هنا أن أُتمِّم القول في نشأة الأصل الأخلاقي، الذي بُنيت عليه ثقافتنا منذ حدث أول خلاف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر، وعمر، وزيد بن ثابت في جمع القرآن العظيم وكتابتِه بيْن دفـَّتَين، ثم ما تلا ذلك مِن طلب التوثق في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما كان مِن أمر علماء الصحابة في الفتوى، ثم ما كان في أمر التابعين ثم مَن بعدهم، حتى نشأ علم الجرح والتعديل، وهو عِلمٌ فريد لا مثيل له عند أمةٍ مِن الأمم، ثم غلبة هذا الأصل الأخلاقي على الثقافة العربية الإسلامية كلها في جمع علومها، وعناية هذه الأمة بإفراد هذا الأصل بالتأليف، كالذي ألَّفوه في آداب العالم والمتعلم، والفقيه والمتفقِّه، وعلم النظر والمناظرة، وعلم الجدل، وعلم آداب الدرس، إلى غير ذلك مما هو اليوم مجهول أو كالمجهول، لانصراف الناس عنه وتركهم جمع شتاته وإعادة النظر فيه.




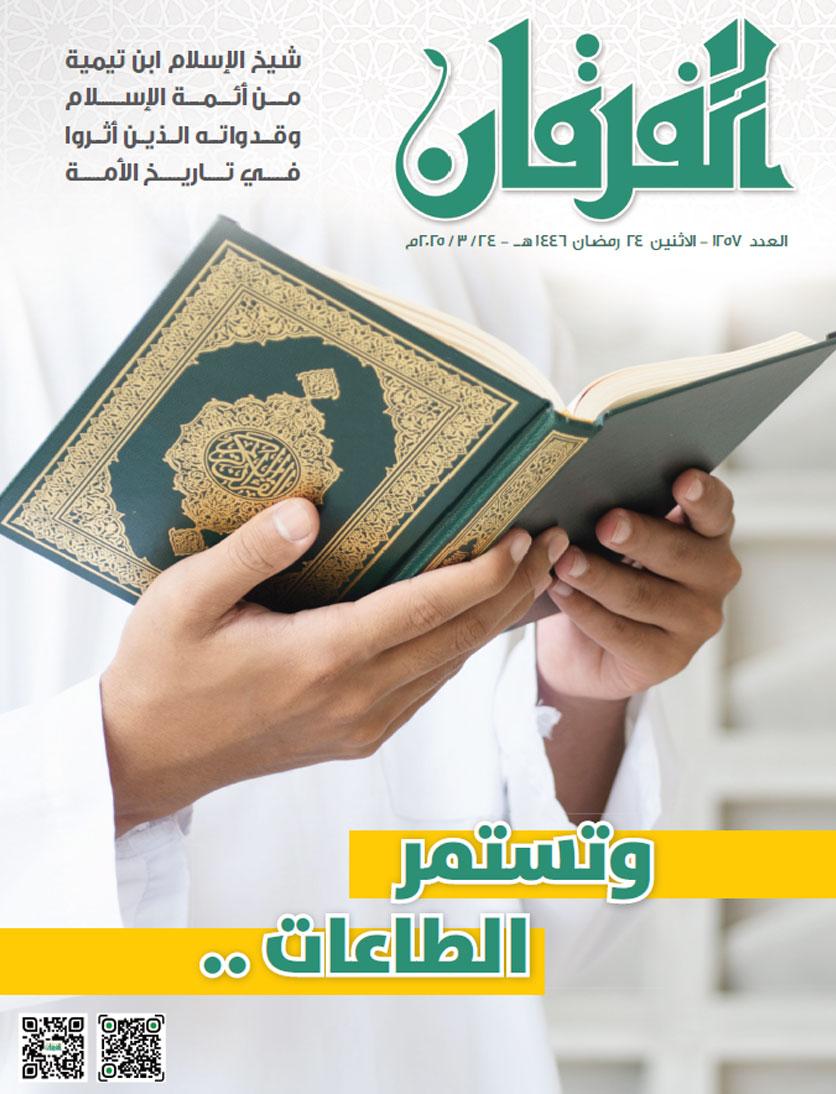







لاتوجد تعليقات