
السنن الإلهية (35) جزاء الإحسان.. الإحسان!
- أدوات الاستفهام في اللغة كلها أسماء عدا ثلاثة، الهمزة و(هل) و(أم)! كان محاضرنا يتحدث عن الإعجاز اللغوي في القرآن، شعرت أنه تعمق أكثر مما يفهم عامة الحضور؛ وذلك أن الغرض مخاطبة المصلين وليس طلبة علم شرعي أو لغوي. بعد المحاضرة خرجت وصاحبي نتجاور. - أظن من رتب هذا اللقاء لم ينبه الدكتور المحاضر أن الحضور من عامة الناس وليس من أهل الاختصاص. - كانت المحاضرة لطلبة السنة النهائية في المعهد الديني، وهكذا أعلن عنها. - لم أنتبه لذلك، ولكن الفائدة كانت جيدة بالنسبة لي، ولاسيما عندما أسهب في شرح {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} (الرحمن:60). - نعم. دونت بعض الملاحظات هنا، وردت (هل) ثمانين مرة تقريبا في كتاب الله -تعالى-، وحرف (هل) يأتي مع الجملة الفعلية، وأحيانا مع الجملة الإسمية. قاطعني صاحبي. - دعنا من هذا الكلام (الصعب)، ماذا عن قول الله -تعالى-: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} (الرحمن:60)؟ - دعني أبحث لك في مصادر أخرى. - الإحسان، يأتي بمعنى الإتقان، كقوله -تعالى-: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ} (السجدة:7). - وورد في الحديث، عندما فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (مسلم). وإذا ورد مطلقا فإنه يعني: «فعل ما هو حسن»، وضده (القبح) وقيل: «الإحسان: هو فعل ما ينبغي فعله من المعروف»، وهو نوعان: الإنعام للآخر، والإحسان في فعله. - والمعنى المراد في الآية من سورة الرحمن؟ - أما الإحسان الأول فهو: (إحسان العبد)، والإحسان الثاني فهو (إحسان الله) -عز وجل- (جزاء من جنس العمل)، ولا شك أن إحسان الله للعبد، أعظم وأجل ولا يقارن به أي إحسان، وهذه سنة من السنن الإلهية، أن جزاء الإحسان، الإحسان. وهل إحسان الله للعبد في الدنيا أم الآخرة؟ - قد يكون في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا فقط، أو في الآخرة فقط. أما إحسان الله للعبد في الدنيا، فهو كل ما يسر العبد من نعمة، وفي الآخرة جزاء فعله الحسن في الدنيا، ولا شك أن هذا أعظم من الأول. قال الله -تعالى- : {لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الزمر:34-35). - إن للإحسان صورا كثيرة ومتنوعة، تتنوع بحسب أنواع الطاعة والبر التي أمر الله بها، ولكل منها جزاؤه وأجره الذي وعد الله به، ومنها: الإحسان مع الله وهو أعظم الإحسان وأفضله وهو الإيمان بالله، وتوحيده، وطاعته، والإنابة إليه، واتباع شرعه، وأن تعبد الله كأنك تراه، وهو مقام الإحسان الذي أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل -عليه السلام- والإحسان في العبادة درجتان: الأولى: أن يعبد الإنسان ربه بقلب حاضر كأنه يراه، الثانية: إذا لم يعبد ربه كأنه يراه، فليعبده كأنه هو الذي يراه، عبادة الخائف منه، الهارب من عقابه. وأما الاحسان مع الخلق : أولى الناس به الوالدان والأم بالدرجة الأولى؛ حيث قال -تعالى-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (الإسراء:23)، ثم الإحسان إلى الأقارب وهذا النوع من الإحسان، هو صلة الرحم الذي أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- - بها، ويكون بحسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة، وتارة بالسلام، وتارة بطلاقة الوجه، وتارة بالنصح، وتارة برد الظلم، وتارة بالعفو والصفح وغير ذلك من أنواع الصلة بحسب القدرة والحاجة والمصلحة. ومنها الإحسان إلى الجار واليتامى والمساكين والإحسان إلى عامة الناس وفي بذل الإحسان للناس ثواب معجل في الدنيا؛ إحسانا من الله -تعالى- للعبد، غير الثواب المدخر له في الآخرة، دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...» (رواه مسلم). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المعروف إلى الناس يقي صاحبه مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» (صحيح الجامع)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر» (صحيح الترغيب). ومنها الإحسان في القول وهو قول أنفع الكلام، الكلام اللين، والقول المعروف ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، والحلم، والعفو والصفح، فجميع هذه الأفعال من القول الحسن؛ حيث أمر الله صراحة بالقول الحسن في قوله -تعالى-: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}. (البقرة:83)، والإحسان في العمل بإتقان العمل وفعله خالصا كاملا لله. وجميع أعمال الإحسان وصوره تصب في الإحسان إلى النفس؛ فالمحسن بوالديه محسن لنفسه ومن يحسن للفقير واليتيم والمحتاج محسن كذلك لنفسه، ومن يحسن بأي وجه من وجوه الإحسان فلنفسه؛ حيث قال الله -تعالى-: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (الاسرا:7). قاطعني صاحبي: - لنرجع إلى الآية من سورة الرحمن في محور حديثنا لأنها تثبت سنة من السنن الإلهية، مع جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. - لك ذلك: قال -تعالى-: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} (الرحمن:60)، هذه الآية جاءت خاتمة للجزاء المعد عند الله -تعالى- للمقربين من عباده المؤمنين، وهم أهل الإحسان الذين يخشونه بالغيب، كما افتتح ذكرهم بقوله -تعالى- {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (الرحمن: 46)، ولكي يكتمل جزاء المحسن عند الله -تعالى- فيجب عليه ألا يرجو على إحسانه مكافأة، ولا ينتظر عليه ثناء، وإنما يرجو به وجه الله -تعالى- والدار الآخرة، والمحسن في إحسانه إما أن يريد الدنيا، كإحسان الكافر والمنافق؛ فهؤلاء ينالون جزاء إحسانهم في الدنيا، وليس لهم في الآخرة نصيب، كما قال الله -تعالى- {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} (الشورى:20)، وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك، يعْني منْ أجْرٍ؟ قال: «إنّ أباك طلب أمْرًا فأصابهُ» (رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط)، وإذا أراد المحسن بإحسانه رضا الله -تعالى- والدار الآخرة، أحسن الله -تعالى- إليه في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون إحسان الله -تعالى- إليه أسرع مما يظن.




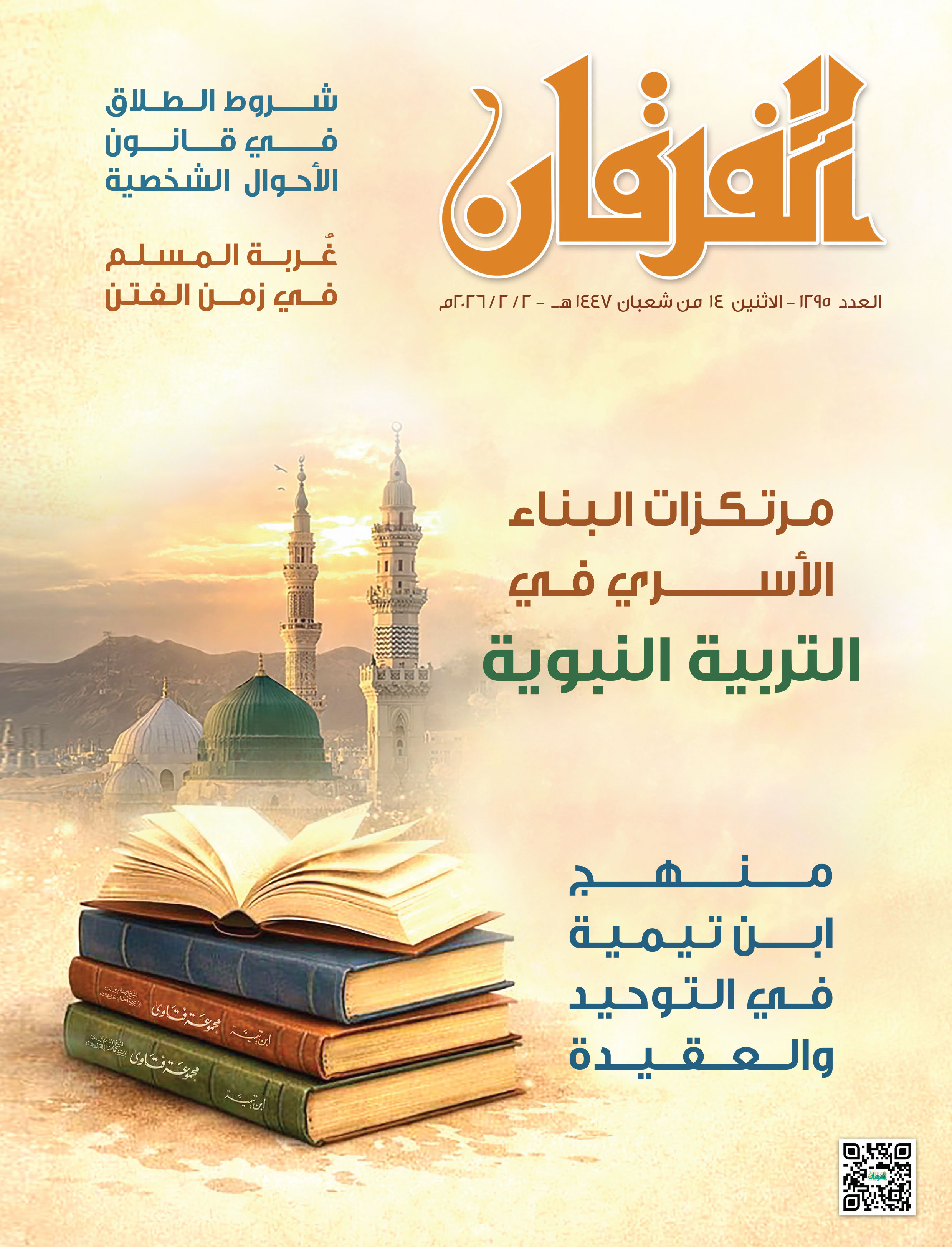







لاتوجد تعليقات