
إشكالية الاستدلال بالخلاف
أمرنا الله -سبحانه وتعالى- بالاجتماع وعدم التفرق، فقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (آل عمران: 103)، وقال أيضاً – محذراً من اتباع سبيل أهل الكتاب -: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (آل عمران: 105) فالخلاف شر كما قال ابن مسعود، وهذا ليس بمانعٍ من وقوع الخلاف، وإنما يبين أن الأمة مأمورة بدفعه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي».
فالواجب على المكلف أن يبحث عن الحق فيما اختلف فيه، وسلوك الطرق المؤدية لمعرفة الحق، وسؤال الله الهداية لما اختلف فيه من الحق، وقد جعل قوم حصولَ الخلاف في مسألةٍ دليلًا أن في هذه المسألة باب سعة للمكلف، يختار من الأقوال فيها ما يناسب الظروف والأحوال، فجعلوا الخلاف حجة في ذاته، واستدلوا على ذلك بأدلة فهموها على غير وجهها، وقواعد للعلماء وضعوها في غير موضعها.
وخطورة هذا القول تكمن في أمرين:
- الأول: أن هذا ليس اتباعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم -، بل هو اتباع للهوى، فالمكلف يختار من الأقوال ما يناسب حاله، وهل اتباع الهوى إلا ذاك؟! وقد حذرنا الله منه، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (الأنعام: 159). وقال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله} (ص: 26).
- الثاني: أنه يؤدي إلى التفلت من أحكام الشريعة؛ فكثير من المسائل حصل فيها الخلاف، وما من عالم إلا وله قول مخالف للدليل، قال سليمان التيمي: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»، والعلماء مجمعون على حرمة تتبع زلات العلماء. ونحن في السطور الآتية نبين ما استدلوا به، ونجيب عنه، ثم نبين الموقف الصحيح من الخلاف، وذلك فيما يأتي:
أولاً: أدلة من يحتج بالخلاف والجواب عنها:
استدل القائلون بأن وجود الخلاف مُسوِّغ للمكلف أن يختار من الأقوال ما شاء بما يلي:
(1) قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود: 118-119).، قالوا: أخبر سبحانه أن الخلاف واقع، وأنه خلقهم لأجل ذلك، فمن قال بأنه لابد من رفع الخلاف: فهو مصادم لهذه الآية.
(2) قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «اختلاف أمتي رحمة، قالوا: وهذا يعني أن الاختلاف فيه توسعة على الأمة.
(3) قول عائشة رضي الله عنها: «ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما»، فهذا يدل على أن للمكلف أن يختار أيسر القولين.
(4) قاعدة: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، فعدم الإنكار دليل على أن للمكلف أن يصير إلى أخف القولين.
والجواب عن هذه الشبهات:
(1) أما الآية فلا دليل لهم فيها؛ إذ معنى الآية أن الله قدّر الاختلاف كوناً، وأراد منا شرعاً أن ندفع هذا الخلاف، ومراد الله الكوني يلزم منه الوقوع، لكن لا يلزم منه المحبة، ككفر الكافر، أما مراد الله الشرعي فيلزم منه المحبة ولا يلزم منه الوقوع، كإيمان الكافر: فقد أراده الله منه شرعاً، لكنه أراد منه الكفر كوناً لا شرعاً.
وأقوال المفسرين لا تخرج عن هذا، فمن قال: خلقهم للاختلاف أراد المعنى الكوني: أي قدرّ سبحانه وقوع الخلاف كوناً، ومن قال: خلقهم للرحمة أراد المعنى الشرعي، أي: أراد منهم -سبحانه- أن يتحروا الحق في الخلاف فيرحمهم، ولا تعارض بين أن يريد منهم الاختلاف كوناً، ويريد منهم دفعه شرعاً.
وكيف يكون الخلاف مطلوباً شرعاً، وقد نهانا الله عنه فقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهبَ رِيحُكُمْ} (الأنفال: 46).
(2) حديث: «اختلاف أمتي رحمة»، ليس بحديث أصلا، فقد نقل المناوي عن السبكي قوله: «وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، وقال الألباني: «لا أصل له».
(3) حديث: «ما خير رسول الله..» إلخ. حديث صحيح، لكن لا دلالة فيه على جواز أن يختار المكلف بين الأقوال؛ إذ إن الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يختار الأيسر فيما فيه اختيار، أما ما كان حراماً فكان رسول الله أبعد الناس عنه، فلا يستقيم الاستدلال بالحديث هنا إلا بعد تقرير كون الاختيار بين الأقوال أمر جائز، وليس الحديث نفسه دليلا على جواز الاختيار بين الأقوال.
(4) أما القاعدة التي ذكروها فهي صحيحة، لكنهم فهموها على غير وجهها؛ إذ القاعدة محلها في عدم الإنكار، وعدم الإنكار لا يعني جواز الاختيار، وتفصيل ما ينكر فيه مما لا ينكر سنذكره عند ذكر أنواع الخلاف في الفقرة الآتية.
ثانياً: الموقف الصحيح من الخلاف
الموقف الصحيح من الخلاف يكون ببيان أنواعه والموقف من كل نوع، ويقع الخلاف على نوعين: خلاف التنوع، وخلاف التضاد.
خلاف التنوع
هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بأن يكون كل واحد من القولين مشروعاً، أو بأن يكون كل من القولين في معنى الآخر لكن العبارتين مختلفتان، أو بأن يكون القولان متغايريْن لكنهما غير متنافيين، وهذا مثل الاختلاف في وجوه القراءات، ومثل الاختلاف في صيغ التشهد الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -، وهذا النوع من الخلاف لا إشكال في المصير إلى أحد القولين؛ لأنه لا تضاد في الحقيقة.
خلاف التضاد
وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد القول الآخر، فما يحكم القول الأول بصحته يحكم القول الثاني بخطئه، وهذا النوع على قسمين:
القسم الأول: الخلاف غير السائغ وهو المذموم
وهو كل ما خالف نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، وهذا النوع يحرم المصير إليه لمن علمه، وينكر على من وقع فيه.
والقسم الثاني: الخلاف الذي يسوغ وهو ما ليس بمذموم
وهو ما لم يكن كذلك، بأن كان له وجه من الأدلة، وهذا النوع يجب على المكلف فيه أن يتحرى الحق قدر طاقته، وذلك بأن يجتهد إن كان أهلاً للاجتهاد، أو يقلد إن عجز عن الاجتهاد، ولا ينكر على المخالف؛ لأنه اتبع الحق في ظنه.
وهذا هو الموقف الصحيح من الخلاف، والحيدة عن هذا الموقف تكون بأحد أمرين:
الأول: بجعل الخلاف كله من خلاف التنوع، وهو القول الذي نرد عليه.
الثاني: بجعل خلاف التضاد كله من قبيل الخلاف غير السائغ.




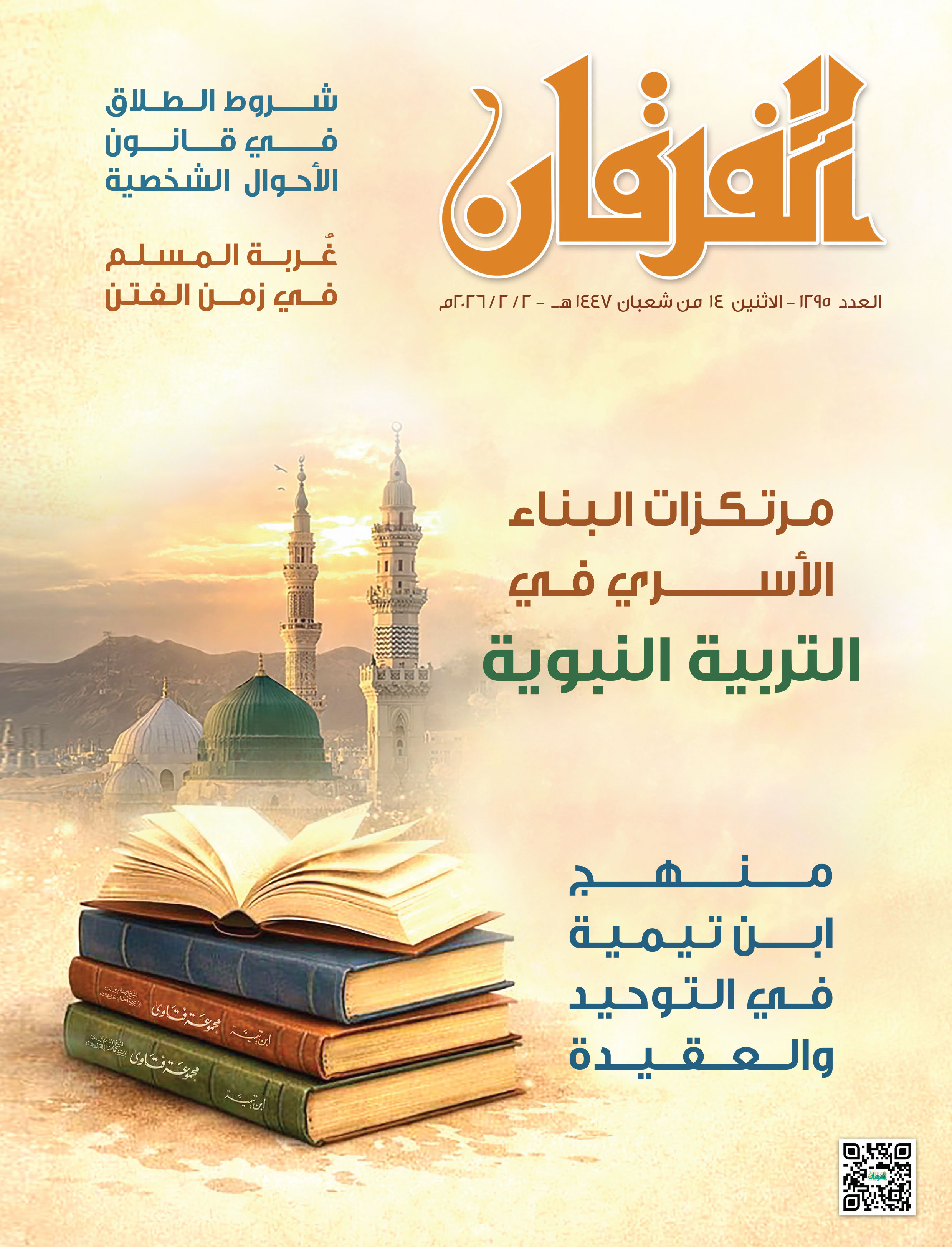







لاتوجد تعليقات