
أعلام وقدوات أثروا في تاريخ الأمة – محاضرات منتدى تراث الرمضاني الخامس – المحاضرة 3 – شيخ الإسلام م ابن تيمية
- طلب شيخ الإسلام العلم منذ طفولته فبدأ بحفظ القرآن وأخذ علوم الشريعة واعتنى بالسنة والتفسير واعتنى بعلم اللغة والأصول حتى تبحر في العلوم النقلية والعقلية
- تميزت حياة شيخ الإسلام ومنطلقاته الأولى بأمور ثلاثة أولها: البناء العلمي وثانيها: الولاء للشريعة بنصوص الوحي وثالثها: النظرة الشمولية العامة
- لم يكن شيخ الإسلام ينظر إلى القضايا والمسائل والبحوث نظرة جزئية وإنما كان ينظر إلى القضية نظرة شمولية ولهذا كان نظره إلى كل قضايا الأمة بميزان معتدل وبنظرة شرعية دقيقة وجامعة
- بدأ ابن تيمية بالتدريس والإفتاء في العشرين من عمره لأنه تأهل من الناحية العلمية والفقهية والعقلية والنقلية ثم بدأ حياته متنقلا بين دمشق والقاهرة تارة يؤلف وتارة يُدرّس وتارة يجاهد
شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة الإسلام الكبار الذين صنفوا وبحثوا في العلوم الشرعية النقلية منها والعقلية، وحديثنا اليوم عن شيخ الإسلام هو حديث عن العلم والتجديد، عن الفقه والتصحيح، عن التأصيل والتفصيل، بل عن الدين من أوله إلى آخره، فابن تيمية -رحمه الله- لُقّب بشيخ الإسلام، وهذا اللقب إنما يطلق على الإمام العالم المتبحر في كل علوم الشريعة، بل يطلق على العالم المتبحر الذي صار عالم ملةٍ، وعالم أمة وهو قائم بعلوم الأمة وواجباتها وبأصول الشريعة وفروعها، قام في ذلك بجهاده العلمي وبجهاده العملي.
والكلام في هذا اللقاء لا يكون عن سيرة هذا الإمام؛ لأن سيرته معروفه ومشهورة، وليس الكلام عن كتبه؛ لأن كتبه مقروءة، محققة، مشهورة، موجوده في المكتبات الإسلامية، بل اليوم لا تجد عالما أو باحثا يبحث في أي قضية من قضايا الشرع إلا وهو ينهل من علوم شيخ الإسلام وأعماله العلمية المتنوعة، وإنما الكلام اليوم عن منهجه، عن منطلقاته، عن أسسه، عن دعوته، عن خصائص علومه وأعماله العلمية والدعوية، بمعنى الكلام اليوم عن الأمور التي لها أثر كبير على الأمة وعلى الأفراد وعلى العلماء وعلى طلبة العلم.مولده وبداياته العلمية
شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- ولد في حرّان وهى منطقه في جنوب شرق تركيا سنة 661 من الهجرة، في ذلك الوقت في بيئته كان التتار قد غزوا بلاد الإسلام؛ فاضطر إلى الانتقال، انتقل والده إلى دمشق ليستقر فيها ويبدأ منذ طفولته بطلب العلم، وبدأ يحفظ القرآن ويأخذ علوم الشريعة ويعتنى بالسنة والتفسير ويعتنى بعلم اللغة والأصول، حتى تبحر في العلوم النقلية والعقلية، بل في بداية تكوينه كان العناية به هو أنه يتلقى أصول العلوم في جميع فنونه وأنواعه سواء ما تعلق بعلم الاعتقاد أم التفسير أم الحديث أم الفقه أم أصول الفقه أم اللغة أم التاريخ، حتى تمكن في فترته الأولى من علوم الشريعة أيما تمكن، فلما بلغ سن العشرين بدأ بالتدريس والإفتاء؛ لأنه تأهل من الناحية العلمية والفقهية العقلية والنقلية، ثم بدأ حياته متنقلا بين دمشق والقاهرة، تارة يؤلف وتارة يُدرس وتارة يجاهد، تارة يوضح الحجة وتارة يرد على الشبهة، فزمانه وأيامه وحياته كانت في جميع تفاصيلها قد اشتملت على العلم والدعوة والطلب والجهاد والنصح والبيان والتصحيح والتحقيق في علوم الشريعة حتى فارق الحياة. ومن ينظر في سيرته -رحمه الله- يرى عجبا؛ ولهذا فهذه السيرة العلمية والأعمال الدعوية والمواقف الجهادية، كانت تصب في خدمة الأمة وفي حفظ وجودها، كما وقد أحاط التتار وتمكنوا في تلك المرحلة أيما تمكن حتى عاشت تلك المرحلة حالة من الضعف والانهيار وحالة من الانقسام، فظهر شيخ الإسلام وكأنه جاء ليلبي حاجة الأمة في ذلك الزمان.منطلقات حياته الأولى
تميزت حياته ومنطلقاته الأولى بأمور ثلاثة، والتركيز على الجوانب المنهجية والتربوية في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعالى.- أولها: البناء العلمي.
- ثانيها: الولاء للشريعة بنصوص الوحي.
- ثالثها: النظرة الشمولية العامة.
أولاً: البناء العلمي
لم يكن -رحمه الله- متخصصا بفن من الفنون، بل اطلع على جميع علوم الشريعة، ولهذا لُقّب بشيخ الإسلام، وهذا اللقب لا يطلق إلا على من كان متبحرا في جميع العلوم وفنون الشريعة، فأعطته ملكة وقوة، فهنا إذا سلمت البدايات ظهرت النهايات، وإذا صحت المقدمات ظهرت النتائج، فكان التأسيس ليس فقط على حفظ القرآن، ليس فقط على حفظ السنة، وإنما التأسيس هو بناء علمي موسوعي، ولهذا فهذه الأمور أثرت فيما بعد في رؤية شيخ الإسلام وفي نظره وفي ثقته وفي فهمه؛ فبدأ ينظر إلى الأمور نظرة شمولية، هذه النظرة الشمولية جاءت من بنائه العلمي الذى كانت العناية فيه بعلوم الشريعة كلها. وهنا مسألة أو فائدة وهي أن علوم الشريعة كالعناصر التي يحتاجها الجسم، لو تخلف عنصر من العناصر أثر على بناء الجسم، كذلك البناء العلمي للداعية ولطالب العلم لا يكتمل اكتمالا صحيحا إلا بالبناء العلمي الموسوعي، بمعنى لو اعتنى طالب العلم بالتفسير أكثر من اعتنائه بالحديث لكان نقصا في بنائه، ومن هنا كانت عناية شيخ الإسلام بعلوم الشريعة كلها.ثانيًا: الولاء الحق
الجانب الآخر في شخصيته -رحمه الله- هو الولاء للحق والانصياع له، الدوران مع العلم والحق، حتى لو كان هذا الحق عند المخالفين، حتى لو كان هذا الحق عند اليهود والنصارى، هذا الدوران مع الحق قبولا ورفضا أثر وساهم في البناء العلمي لشخصية شيخ الإسلام بن تيمية.ثالثًا: النظرة الشمولية
النقطة الثالثة وكأنها هي ثمرة الولاء للشرع والدين والحق والبناء العلمي الصحيح أثمرت نقطة ثالثة في شخصية شيخ الإسلام وهي النظرة الشمولية، فلم يكن شيخ الإسلام ينظر إلى القضايا والمسائل والبحوث نظرة جزئية، وإنما كان ينظر إلى القضية نظرة شمولية ينظر إلى جميع جوانبها، إلى مقدماتها، إلى أسبابها وآثارها ولوازمها ومتعلقاتها، هذه النظرة الشمولية كانت أساساً في بناء شخصية شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، ولهذا كان نظره إلى كل قضايا الأمة بميزان معتدل وبنظرة شرعية دقيقة جامعة، بخلاف من لم يمتلك هذه الصفات تراه يركز على جزئية ويدع باقي الجزئيات، لهذا معالجة شيخ الإسلام للوازم الأمة في قضايا الدين لمسائل الشرع كان ينظر إليها من مختلف جوانبها.هذا هو واقع شيخ الإسلام
هذه الأمور الثلاثة هي أساسيات في تكوين شخصية شيخ الإسلام، وهو سيواجه تحديات وستفرض عليه واجبات وسيقوم بمهمات، انطلق هنا في التعامل مع الواجبات، واجبات كثيرة، تحديات عظيمة، التتار سيطروا على بلاد الإسلام باستثناء دمشق والقاهرة وبعض البلاد، التفرق في الأمة والجهل وظهور الفرق الضالة كما سنبين، انشغال الناس بالحياة الدنيا، الاقتتال بين الناس على حظوظ الدنيا، الفتن السياسية، البدع العملية والاعتقادية، الأعداء يتربصون بالإسلام.ثلاث قواعد مهمة
هذا هو واقع شيخ الإسلام، كيف تعامل مع هذا الواقع؟ كيف عالج؟ كيف انطلق وهو العالم الرباني الموسوعي الذي عنده ولاء للحق ويمتك نظرة شمولية في فهم الدين والدنيا؟ انطلق أيضًا من ثلاث قواعد مهمة:القاعدة الأولى: فهم الواقع وتعيين الواجب
أخبر شيخ الإسلام عن القاعدة الأولى في كتابه منهاج السنة، فقال: أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع، هذه هي القاعدة الأولى، شيخ الإسلام بدأ في التعامل في الإصلاح وفي التغيير من فهم الواقع وفي تعيين الواجب وفي جعل الواقع تحت الواجب، هذا فقه سديد، فلم يكن معزولا عن واقعه، ولم يكن جاهلا بواجبه، لأننا اليوم قد نرى إنسانا فقيها بالواقع وفي حيثياته، لكن لم يكن عالما بالواجب، والعكس قد يكون الإنسان عالما بالواجب الشرعي وبالنصوص والأدلة، لكن لا يفهم الواقع. قد يكون يفهم هذا وهذا، لكن لا يتمكن من إنزال الواقع تحت الواجب أو من تنزيل الواجب على الواقع بالحكمة والسماحة والرفق.القاعدة الثانية: تحري الحق ورحمة الخلق
ثم انطلق -رحمه الله- من قاعدة ثانية عظيمة، وهي أن أهل السنة يتحرون الحق ويرحمون الخلق، تحري الحق في كل جزئية، هذا حق وهذا باطل، هذا واجب وهذا مستحب، هذا مكروه وهذا محرم، هذه بدعة وهذه سنة، اعتناء بالثوابت وتوصيف للشيء بوصفه الشرعي. كيف أتعامل مع الخلق إذا خالفوا هذا الحق، أتعامل معهم بالرحمة، في الحق هناك تمسك وقوة وثوابت، وفي التعامل مع الخلق هناك رحمة وحكمة، من هنا انطلقت الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-.القاعدة الثالثة: الإمامة في الدين
وهي قاعدة مهمة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ألا وهي الإمامة في الدين؛ فقد كان قدوة مؤثرا فاعلا، كما قال -رحمه الله-: الإمامة في الدين تُنال بالصبر واليقين، بالصبر والاحتساب والمصابرة بالعلم واليقين، واستند إلى قوله -تعالى-: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}. إذًا منطلقات شيخ الإسلام بعد الحصانة العلمية والرؤية الشمولية، أنه بدأ يعالج الواقع من فهم الواجب وتصور الواقع، من تحرى الحق ورحمة الخلق، من إمامة الناس بالصبر واليقين، أي التأثير في المجتمع، فلكي تكون مؤثرا لابد أن تكون صابرا ومتيقنا؛ لأن الصبر بلا يقين لا يجعلك إماما، ويقين بلا صبر كذلك، ولهذا نرى كثيرا من الدعاة في زماننا قد يتربون على بعض علوم شيخ الإسلام وقد يقرؤون بعض كتبه، لكن لا يتصفون بقاعدة الصبر، وإنما استعجال النتائج أو ربما عندهم صبر واحتساب، لكن ينقصهم العلم والفقه؛ لهذا ترى العجب منهم ترى التشدد، ترى الغلوّ وترى القرارات الجائرة والتصرفات الحائرة؛ لأنهم لم يستندوا إلى القاعدة القرآنية حتى تكون مؤثرا وأنت تواجه هذه التحديات وهذه الصعاب لابد أن تتصف بالصبر واليقين، فهذه ثلاث قواعد انطلق منها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.أسس في إقامة الحجة ورد الشبهة
أسس شيخ الإسلام أسسا في إقامة الحجة وفي رد الشبهة، وفي الانصياع إلى الحق وفي رد الباطل، وفي إظهار حجج القرآن والسنة، يحتاج أن يُظهر الحجة الرسالية، ويوضح القيم والمبادئ القرآنية، ويعزز المعاني السلفية في آثار الصحابة والتابعين، فكان لابد من آلات يستند إليها، فهنا بنى على أمور ثلاثة أيضا، وأحب أن أكون معكم في هذه الثلاثيات، البناء والولاء والشمولية، ثم فهم الواجب، وتصور الواقع، وتحري الحق، ورحمة الخلق، إمامة في الدين تقوم بالصبر واليقين هنا لابد من آلة، فاعتنى شيخ الإسلام بأمور ثلاثة، وبيّنها بيانا مفصلا في كل كتبه بل ألّف بعض المؤلفات لأجلها.أولا: الاعتناء بالعلم الشرعي
أول هذه الأمور هو الاعتناء بالعلم الشرعي؛ فقد بيّن أن العلم ليس أقوالا ولا معلومات ولا ظنونا ولا زخارف القول ولا حواشي ولا مجرد عناوين لا، يقول -رحمه الله-: العلم إما نقل مصدّق أو نظر محقق. إذًا لابد من الاعتناء بالعلم الشرعي في نهوض الأمة؛ فلمّا أراد شيخ الإسلام أن يبدأ بنهوض الأمة في تفكيرها بدأ بالعلم وحدد معنى العلم، أحياناً تحث الناس على العلم، لكن أي علم؟ العلم هنا هو نقل مصدق أو نظر محقق.ثانيا: الاعتناء بالنقل
نقل الأخبار ونقل الأحاديث ونقل السنن ونقل الروايات ونقل المذاهب، ثم العقل الصريح والصحيح، إذًا استند شيخ الإسلام في حركته العلمية ليس إلى شعارات ولا تصريحات ولا إلى رموز وكلمات رمزيه أو أفكار، أبدًا، وإنما استند في حقيقة الأمر -رحمه الله تعالى- إلى العلم الشرعي المحقق، وإلى النقل الصحيح المصدّق، إلى العقل الصريح المؤيد بالفطرة والشرعة، هنا بدأ يؤلف، يناظر، يكتب، ينصح في هذا الإطار.كتبه ومنهجه -رحمه الله-
فلو نظرنا إلى كتبه، إما: مسائل علمية أو نقول شرعية أو أمور عقلية، حتى ألّف كتاب (درء تعارض العقل والنقل)، وبيّن أن النقل هنا استند أيضًا وركز على أمرين مهمين من هذه الثلاثة، النقل والعقل والعلم، ونحن في هذا الزمان ابتلينا، فقد تجد رجلا عنده حفظ، عنده علم، قارئ على الشيوخ، لكن مشكلته في العقل! عقليته ليست ناضجة، أو مشكلته في الفكر، فكره ليس صحيحا، هذه الثلاثة ركز عليها شيخ الإسلام في بناء الشخصية الدعوية العلمية، نقولك صحيحة، تصوراتك العقلية سليمة، علومك ثابتة ومحققة، وهذا هو الذي يحتاجه الجيل اليوم.أصول مهمة في منهج شيخ الإسلام
فالأزمة في واقعنا المعاصر هي في التصورات أكثر منها مجرد أزمة في النقولات، فالجميع الآن يستدل بالآيات والأحاديث الصحيحة، لكن الإشكال هو عدم التكامل، لهذا انتهى شيخ الإسلام إلى أصول مهمة:- الأصل الأول: أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فلا يوجد تعارض بين العقل وبين النقل، وبدأ يجادل أهل المنطق والفلسفة بهذه القاعدة العظيمة يجعلها أساساً في دعوته وفي مناظراته.
- والأصل الثاني: أن الشرع لا يتعارض مع القدر، فالأمر الإلهي، الأمر إما أن يكون أمراً بالشرع، وإما أن يكون أمراً بالقدر، والشرع جاء يوضح القدر، والقدر جاء يعين على الامتثال للشرع، وازن بين السنن الشرعية والسنن الكونية، هذه نظرة عظيمة رد فيها على غلاة المتصوفة، ووحدة الوجود، والقدرية والجهمية.
- والأصل الثالث: وجوب النظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان، فالشريعة كاملة بأحكامها بفروعها، في حِكَمها، في مقاصدها، في أبوابها ونصوصها عامة شاملة لأفعال المكلفين إلى قيام الساعة،ولهذا شيخ الاسلام في كل قضية يرجعها إلى أصولها وكلياتها وقواعدها.
تطبيق هذه القواعد وتحقيقها
عاش شيخ الإسلام مع هذه القواعد وعمل لتطبيقها وتنزيلها وتحقيقها، حتى صار كل مصلح بعد وفاة شيخ الإسلام مضطر يحتاج عند إصلاحه سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دينيا أن يجعل كتب شيخ الإسلام عنوانا وميدانا لبحثه وتطبيقه، إذا عالج الإنسان الواقع بهذه المنطلقات كانت حياته دعوة إلى الله -عزّ وجل-، لم يكن شيخ الإسلام يؤثر على الواقع فقط، كتبه وفتاويه ومسائله وأجوبته، وإنما كان يؤثر على الواقع بسلوكه ودعوته، وبطريقة عرضه للدين، وأول تلك المقدمات هي أنه أنزل نفسه منزلة الإيثار، فأسقط حقه لحق الله، لم يتعقب المخالفين والخصوم والمناوئين له، بل عفا عنهم جميعا، هذا هو الأساس وهو التدريج في دعوته، لكن الناظر في حقيقة الأمر في معالجات شيخ الإسلام للواقع وفي ذلك الوقت منكرات كثيرة، وهيمنة التتار على بلاد المسلمين، اليهود يناظرون لنشر دينهم، وكذلك النصارى، ظهرت فرق كثيرة وبدع شهيرة وانحرافات خطيرة والناس في غفلة وفي فتنة وفي بدعة، كيف عالج هذا الواقع؟ لم يعتزل الناس في عزلة مذمومة، ولم يكن قاضيا عليهم في أحكام جائرة، ولم يجعل منهجه في الأصل هو التبديع، ولم يُكَفّر، بل همه هو بيان مقالة المخالف، وبيان حال المخالف عند الحاجة.منطلق الإصلاح عند ابن تيمية
كان منطلق التغيير عند شيخ الإسلام قول الله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ}، فجعل منطلق الإصلاح من النفس فألّف كتاب (الاستقامة) في مجلدين، ثم بدأ بفقه التدرج، في هذا الإطار هو جعل أساس الإصلاح في بناء النفس هو صلاح القلب ومحبته بالتوحيد والاعتقاد والامتثال؛ فألّف كتاب (قاعدة المحبة) وهو مجلد، انظر إلى هذه المنطلقات في حياة شيخ الإسلام، وانطلاقاته حتى في التأليف والتصنيف تستند إلى قاعدة إصلاحات هذا الواقع وكأنه وُلد في ذلك الزمان يجتهد في تقريب وفي ترغيب الواقع بالواجب، وفي إقامة حجة الواجب على الواقع، وفي إصلاح الواقع في أمراضه وتفرقه وانقساماته وجهله وظلمه بعدل وعلم وحكمة الواجب، وهذا فقه دليل، ونظر سديد.تعامل شيخ الإسلام مع الواقع
لما نظر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى الواقع، وتكلم في تشخيص أمراضه وعلله، وتكلم في السيئات والمفاسد، لم يكن يُظهر ذلك لمجرد الانتقاد أو التوبيخ، وإنما تعامل مع هذه القضية بنظر الطبيب الحكيم، فجعل قاعدة استند في معالجة الواقع وهي أن كل خلل في هذا العالم سواء بالاعتقاد أم في الفروع، سواء خلل في الآداب والأخلاق أو في الاعتقاد والاتباع، سواء خلل في الدين أو في الأموال، والخلل في هذا العالم إنما يقع إما بسبب الإعراض عن الفطرة أو الإعراض عن الشريعة، فجعل الكمال للإنسان في سلامة الفطرة، وفي الامتثال للشرعة، وجعل أصل الإصلاح في القلب، ولوازم ذلك على الظاهر، فبدأ بإصلاح الفطرة والباطل مع إبقاء فقه التلازم في إصلاح الظاهر، وبدأ يبين صور الانحراف وتأثير العلاقة بين الفطرة والشرعة من جهة، والتأثير بين الظاهر والباطن من جهة أخرى، حتى ألّف كتابه العظيم الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، أي مخالفة كل من يجب مخالفته من أهل الكفر والضلال والأهواء؛ لأن في المشابهة الظاهرة لهم تأثير قوي على الباطن.



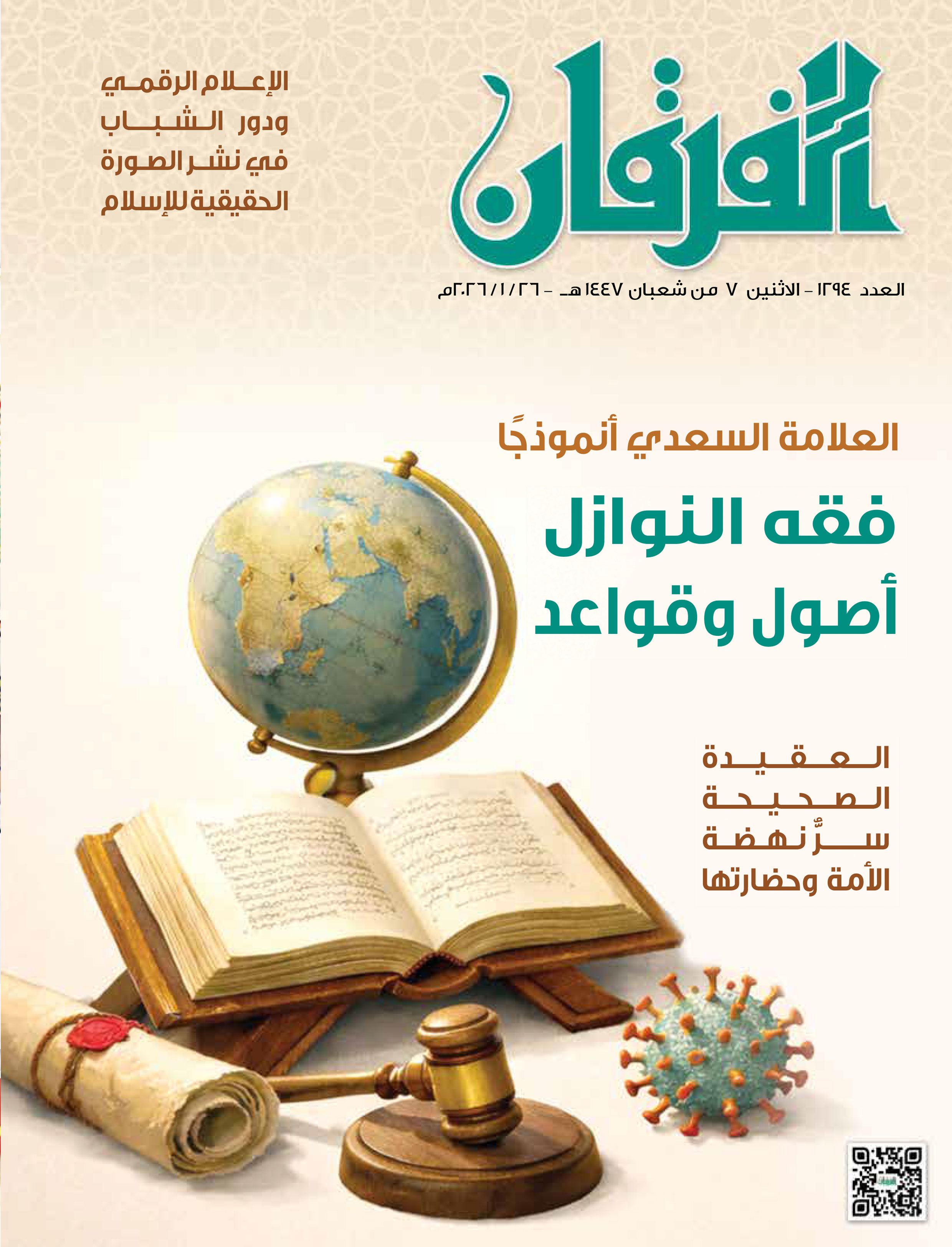







لاتوجد تعليقات