
أدّب ولدك بالأمثال (8) ظن الرجل قطعة – من عقله
- من أشرف ثمرة العقل معرفة الله تعالى وحسن طاعته والكف عن معصيته
- من أراح عقله من سوء الظن وطهر قلبه من اتهام الناس بغير علم عاش سعيدًا مرتاح البال
- الموفق من هداه الله -تعالى- إلى الطريق المعتدل ورزقه العلم النافع والتجارب المفيدة فصار ظنه تابعا لعقله وعقله منقاد للشرع المنزل
هذا المثل حكاه الميداني عن الأصمعي، وهو يتناول أمرين لازمين لكل من أراد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهما العقل والظن، بعد توفيق الله -تعالى- وهدايته، أما العقل فقد تنوعت تعريفاته في اللغة والاصطلاح، وله أسماء متعددة تدل على وظائفه وتبين فضله، كاللبّ، والحجر، والحجى، والقلب.
والعقل في اللغة: المنع، وسمي به عقل الإنسان؛ لأنه يمنعه من المهلكات والقبائح. وأما في الاصطلاح فيطلق على أربعة معان:- أولا: الغريزة التي في الإنسان: فبها يعلم ويعقل، وهي فيه كقوة البصر في العين والذوق في اللسان، وهي مناط التكليف، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان.
- ثانيا: العلوم الضرورية: وهي التي لا يخلو منها عاقل، كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات.
- ثالثا: العلوم النظرية: وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، وتفاوت الناس فيها أمر جلي.
- رابعا: الوقار والرزانة: كما قال الأصمعي عن العقل: «الإمساك عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على الحسن».
تقسيم العقل عند الأصفهاني
ويقسم الراغب الأصفهاني في كتابه: (الذريعة) العقل إلى: عقل غريزي، وهو القوة المتهيئة لقبول العلم، ومكتسب ينمو ويزداد بحسب ما يحصل له من العلوم الدينية والتجارب الدنيوية، ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العلاقة التكاملية بقوله: «العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها»، ولهذا نقل عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: «ما اكتسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى». وقال الأصفهاني: «من أشرف ثمرة العقل، معرفة الله -تعالى-، وحسن طاعته، والكف عن معصيته». فالعاقل يعرف من تدينه، وسلامة منطقه، واشتغاله بنفسه، واستعداده لآخرته. وأما الظن في اللغة فهو مصدر الفعل (ظن الشيء ظنا) أي: علمه بغير يقين، ويقال: ظن بفلان أي: اتهمه.استعمال الظن في القرآن الكريم
وقد جاء في القرآن استعمال الظن بمعنى (العلم واليقين) كما في قوله -تعالى-: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ}، وقوله -سبحانه-: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. واستعمل الظن بمعنى (الشك) كما في قوله -تعالى- : {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}. واستعمل في القرآن بمعنى (التهمة) كما في قوله -تعالى- : {جْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ} قال ابن كثير: «يَقُول -تعالى- نَاهِيًا عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ عَنْ كَثِير مِنْ الظَّنّ، وَهُوَ التُّهْمَة وَالتَّخَوُّن لِلْأَهْلِ وَالْأَقَارِب وَالنَّاس فِي غَيْر مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ بَعْض ذَلِكَ يَكُون إِثْمًا مَحْضًا فَلْيُجْتَنَبْ كَثِيرٌ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا».واقع كثير من الناس
فهذا المثل: (ظن الرجل قطعة من عقله) يبين لنا واقع كثير من الناس، فبعضهم حسن الظن إلى درجة السذاجة والغفلة، وبعضهم سيء الظن إلى درجة تخوين الآخرين واتهامهم بالسوء في كل ما صدر منهم من قول أو فعل بلا حجة ولا برهان، ولا شك أن هذه الظنون المتقابلة لم تأت من فراغ، وإنما هي انعكاس لتلك العقول، وتعبير عن تلك القلوب والنفوس.الطريق المعتدل والسبيل المقتصد
والموفق من هداه الله -تعالى- إلى الطريق المعتدل والسبيل المقتصد، ورزقه العلم النافع والتجارب المفيدة، فصار ظنه تابعا لعقله، وعقله منقاد للشرع المنزل، فلا يكون مغفلا يقوده كل خبيث سيء القصد، ولا يصير شكاكا يتهم الناس بلا بينة، ويصدر عليهم أحكاما بلا دليل.حسن الظن بالله -تعالى
فمن الظن التابع للعقل المنقاد للشرع حسن الظن بالله -تعالى-، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله -تعالى-» أخرجه مسلم، قال النووي: «ومعنى حسن الظن بالله -تعالى- أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه». وقال الله -تعالى في الحديث القدسي-: «أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله» أخرجه أحمد. ومنه حسن الظن بالمسلم كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن غر كريم، والفاجر خبّ لئيم» أخرجه أبو داود، وجعل المؤمن غرا بسبب سلامة صدره وحسن الباطن والظن بالناس، فكأنه لم يجرب بواطن الأمور، فترى الناس منه في راحة لا يتعدى إليهم منه شر.سوء الظن بالمسلمين
وبعكس هذا سوء الظن بالمسلمين بلا دليل ولا برهان، وهو محرم، قال القرطبي: «وَأَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الظَّنّ الْقَبِيح بِمَنْ ظَاهِره الْخَيْر لا يَجُوز»، قال -تعالى- : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. وقال ابن سعدي: «نهى الله -تعالى- عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء، الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به، حتى يقول ما لا ينبغي، ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه». قال القرطبي: «لَا تَظُنُّوا بِأَهْلِ الْخَيْر سُوءًا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ ظَاهِر أُمُورهمْ الْخَيْر»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنّ! فَإِنَّ الظَّنّ أَكْذَب الْحَدِيث» متفق عليه. قال النووي: «المراد النهي عن ظن السوء، قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك، قال النووي: ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به». وعن ابن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله -تعالى- حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيراً». أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.السبيل إلى السعادة وراحة البال
فمن أراح عقله من سوء الظن، وطهر قلبه من اتهام الناس بغير علم، عاش سعيدًا مرتاح البال، واشتغل بنفسه عن الآخرين، واعتنى بواجباته الدينية والدنيوية دون تضييع الأوقات والطاقات في مراقبة الناس والحكم عليهم بلا برهان، والتسلي بمتابعة أخبارهم الصادقة والكاذبة، والخوض في خصوصياتهم، والاستطالة في أعراضهم، والوقوع في الغيبة والشماتة والسخرية والتجسس وغيرها من المحرمات والكبائر الموبقات، وسبب ذلك في كثير من الأحيان العقول الجاهلة والنفوس المريضة والأخلاق الرديئة، والفراغ القاتل، وطول الأمل، وسوء العمل نسأل الله -تعالى- العافية لنا وللمسلمين.



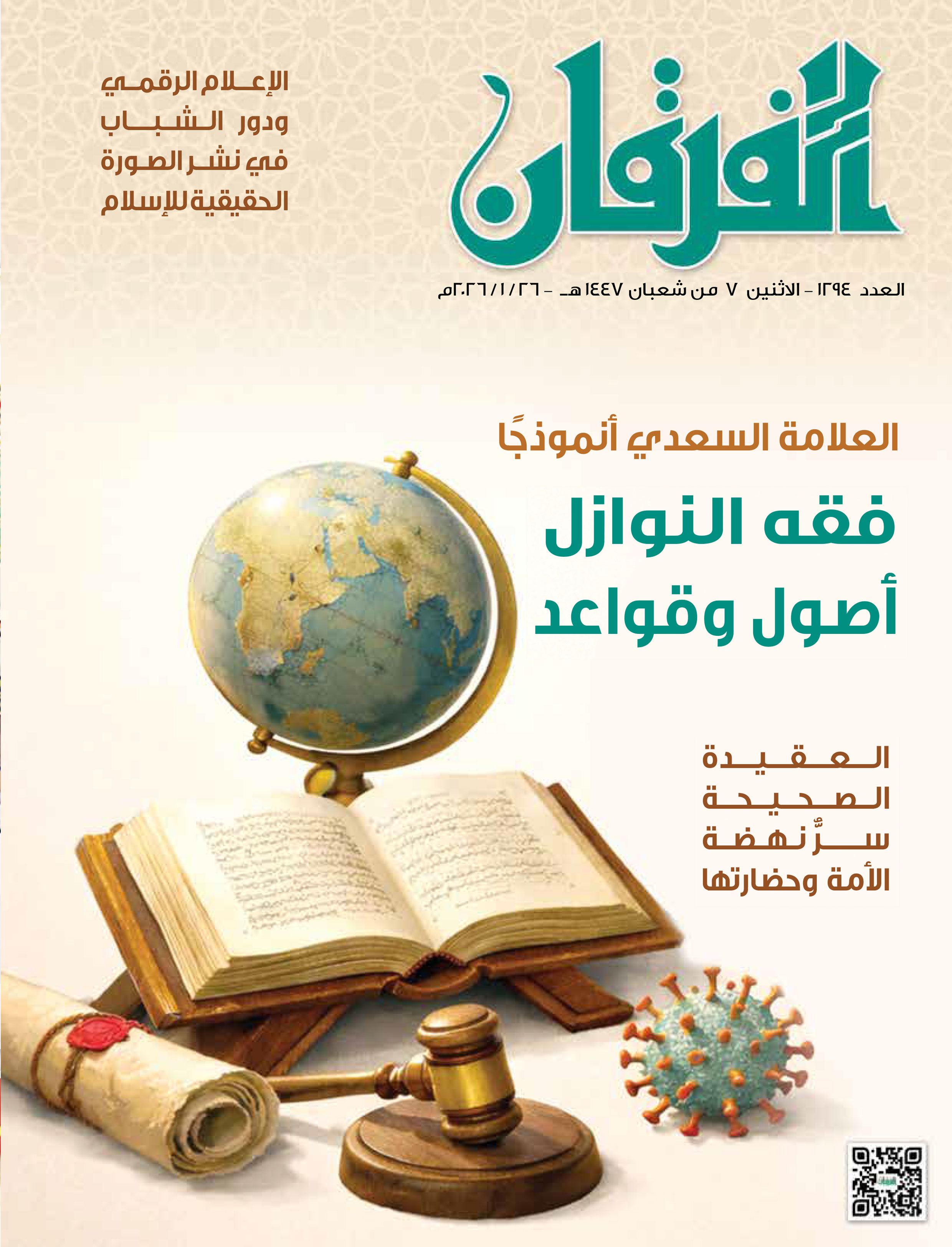







لاتوجد تعليقات